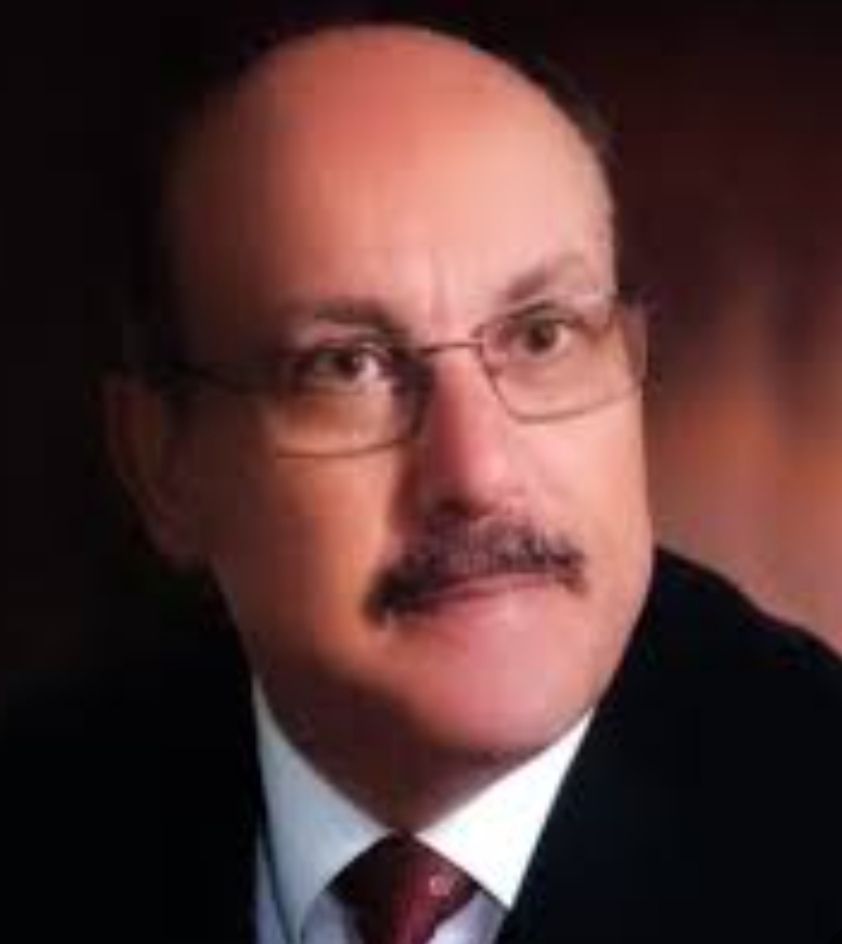كثيرون من العرب المُحبَطين في هذه الآونة من التاريخ بدأوا يتساءَلون حول «قوميتهم»، أو هويتهم العربية: هل ما زالت قائمة، وهل ما زالت قادرة على أن تكون هوية جامعة يلتف حولها كل العرب بغض النظر عن تبايناتهم الدينية، والطائفية، والطبقية؟
إنّ المتأمل في نشوء الدول وتطورها يلاحظ بكل وضوح أن «العنصر» أو «العرق» كان هو الأساس في نشوء الدول والامبراطوريات تاريخياً فالدولة المصرية القديمة قامت على أكتاف الإنسان «المصري»، والامبراطورية الصينية القديمة قامت على أكتاف الإنسان «الصيني»، وكذلك الهندية، والآشورية والسومرية واليونانية وغيرها، والواقع أن العامل الديني بدأ يلعب دوراً أكثر أهميةً (مع بقاء العامل القومي هاماً) مع بزوغ الامبراطورية الرومانية التي اعتمدت الديانة المسيحية (بعد ظهورها بــ 300 سنة تقريباً).
واصطبغت بها حتى بعد انقسامها إلى الامبراطورية الرومانية الغربية (روما)، والامبراطورية الشرقية البيزنطية (القسطنطينية قبل فتحها على يد السلطان العثماني محمد الفاتح عام 1453م).
وقُل مثل ذلك في الدول الإسلامية حيث ظهر العامل الديني جلياً ولكن مع بقاء العامل القومي هاماً فالعرب كانوا «مادة الإسلام» على حد تعبير الخليفة عمر بن الخطاب، والدولة الأموية كانت «عربية أعرابية» والدولة العباسية كانت » أعجمية خراسانية» على حد تعبير الجاحظ، وحتى في الدولة العثمانية–وهي آخر الدول الإسلامية التي حكمت لما يزيد عن 400 عام وفي ثلاث قارات (آسيا، إفريقيا، أوروبا)–فقد كان العنصر- «العثماني» أو «التركي» هو المهيمن والبارز وصاحب التأثير الأقوى.
ومع تراجع دور العامل الديني في نشوء الدول والامبراطوريات خلال القرن العشرين برز دور الأيديولوجيا (ولكن مع بقاء العامل القومي هاماً) حيث نشأ الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى (1917 – 1991) مستنداً إلى الأيديولوجية الشيوعية الأممية (يا عمال العالم اتحدوا)، وبرزت الولايات المتحدة كقوة عظمى أخرى مستندةً إلى مرجعية رأسمالية، ولكن المدقّق يلاحظ بوضوح أن «الروس» كانوا هم الأساس في الاتحاد السوفياتي (تألف من خمس عشرة جمهورية متعددة الأعراق والأديان) كما أن «الأنجلوساكسون» هم الأساس في التركيبة الأمريكية حيث يُعّبر عن هوية المواطن الأمريكي العادي بأنه (Wasp) أيّ أبيض (White)، وأنجلوساكسون (AS)، وبروتستانتي (P).
أما في أوروبا فقد تبلورت النزعة القومية تماماً وبرزت دول فيها على هذا الأساس كبريطانيا (إنجلترا للانجليز)، وفرنسا (فرنسا للفرنسيين)، وألمانيا، وإيطاليا حيث توحدتا واكتسبتا شخصيتهما وهويتهما على هذا الأساس القومي.
وإذا خرجنا من القارة الأوروبية فإننا نجد أن الشعوب تبحث عن هويتها القومية الجامعة: هذا ما يحصل في تركيا، وإيران وحتى الهند، وبرغم ديموقراطيتها وتعدديتها فإنها محكومة الآن من قبل الحزب «القومي الهندوسي»، وحتى الصين التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني تُحكم اليوم بأيديولوجية شيوعية «ذات خصائص صينية!»، وإن مما لا شك فيه أن عرقية «الهان» هي المهيمنة وهي التي تطبع البلاد بطابعها القومي المميز.
إن كل ما سبق لا يعني بالتأكيد «نقاء» القوميات وقيامها على ذات الدم الواحد فهذا مستحيل في الواقع ومرفوض علمياً بسبب تفاعل الانسان مع أخيه الانسان من خلال التجارة، والحروب، والتزاوج وغير ذلك، ولكن ما لا نستطيع أن ننفيه هو أن العامل القومي (بالمعنى الثقافي بعيداً عن التعصب والشوفينية) هو العامل المقرر (Determinant factor) في وحدة الشعوب، وتماسكها، والتفافها حول علم واحد، وبالطبع فإنّ الأنظمة السياسية القومية قد تكون ذات طابع استبدادي، أو ديموقراطي، ولكن من المؤكد أن هذه الأنظمة تعتمد في ضمان لُحمة شعوبها وانسجامها على العامل «القومي»، ولعلنا نستذكر في هذا السياق أن «ستالين» الشيوعي الذي قاد الاتحاد السوفييتي إلى النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)، استدعى خلال الحرب الهوية القومية الروسية (روسيا الأم) أكثر مما استدعى الهوية الأيديولوجية الشيوعية لمواطني بلاده، ويمكن أن نلاحظ أمراً ذا دلالة في ذات الاتجاه وهو أن إيران التي ترفع شعارات الإسلام تسمي نفسها «جمهورية إيران الإسلامية» أيّ أن البعد الإيراني الفارسي أسبق من البعد الإسلامي، كما أن أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان الإسلامية الراديكالية تسمي نفسها رسمياً «إمارة أفغانستان الإسلامية»، أيّ أنّ البعد القومي الأفغاني له الأولوية على البعد الإسلامي!.
هل معنى ذلك أن العوامل الأخرى: الدينية، والايديولوجية وغيرها لم تعد مهمة في تقرير مصائر الدول، ونشوئها، وتطورها؟. بالطبع لا إنها كانت مهمة وسوف تضل مهمة، ولكن السؤال الذي طرحناه في بداية هذه المقالة وبالقياس إلى ما حصل تاريخياً وما هو قائم الآن هو: هل زالت أهمية العامل القومي أم تكرّست؟
وللعرب بعد ذلك أن يتأملوا وأن يستنتجوا أنّ هويتهم العربية هي الوحيدة القادرة على تحريرهم، وتوحيدهم، ونقلهم من وضعية الكيانات الضعيفة المهمشة إلى وضعية الدول الكبيرة والمهمة ذات الشأن!.