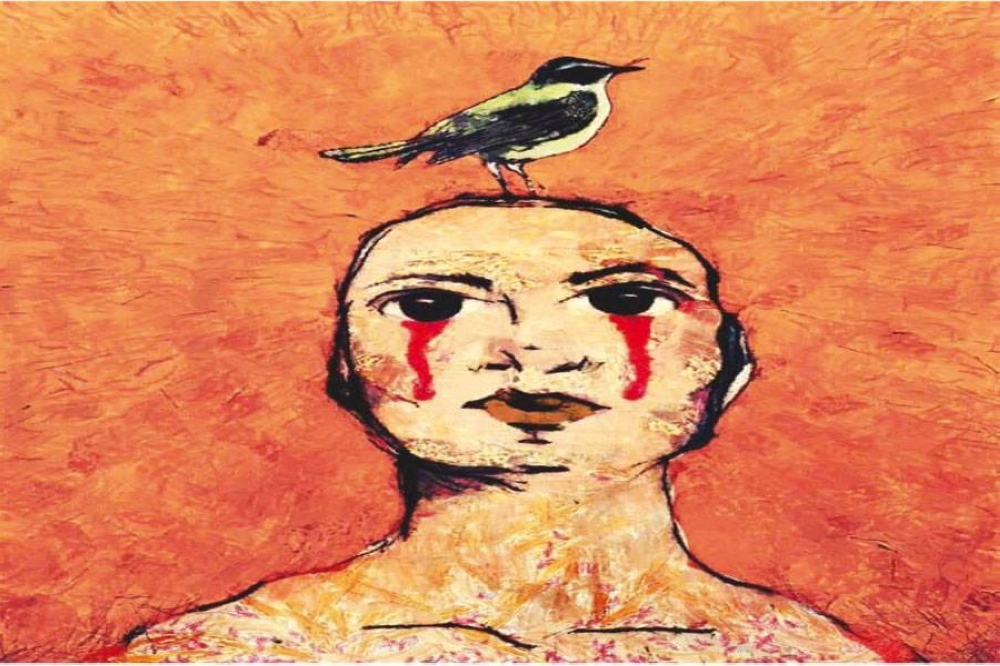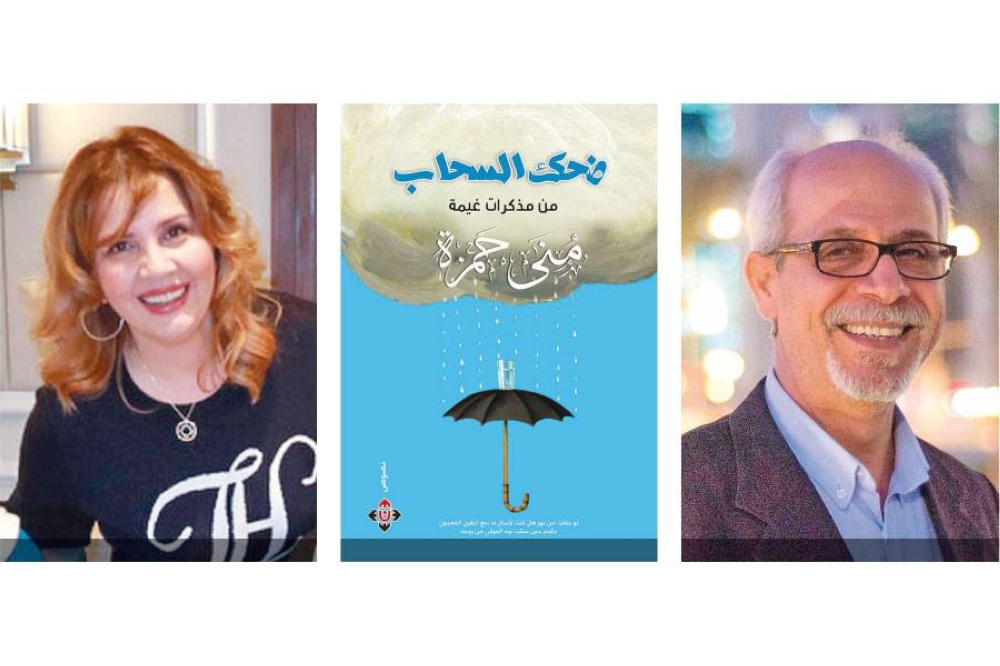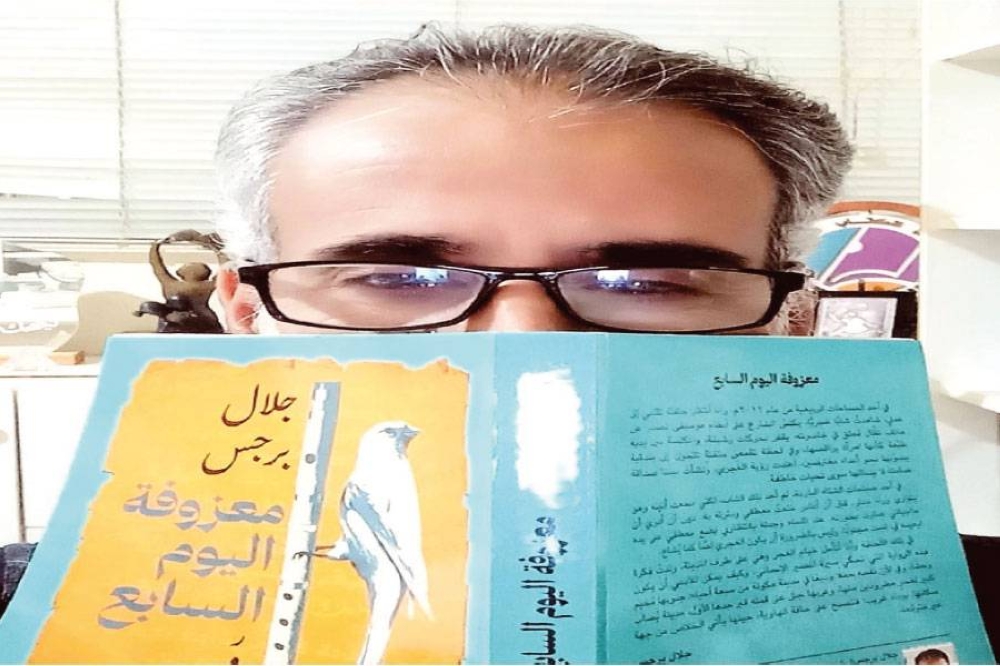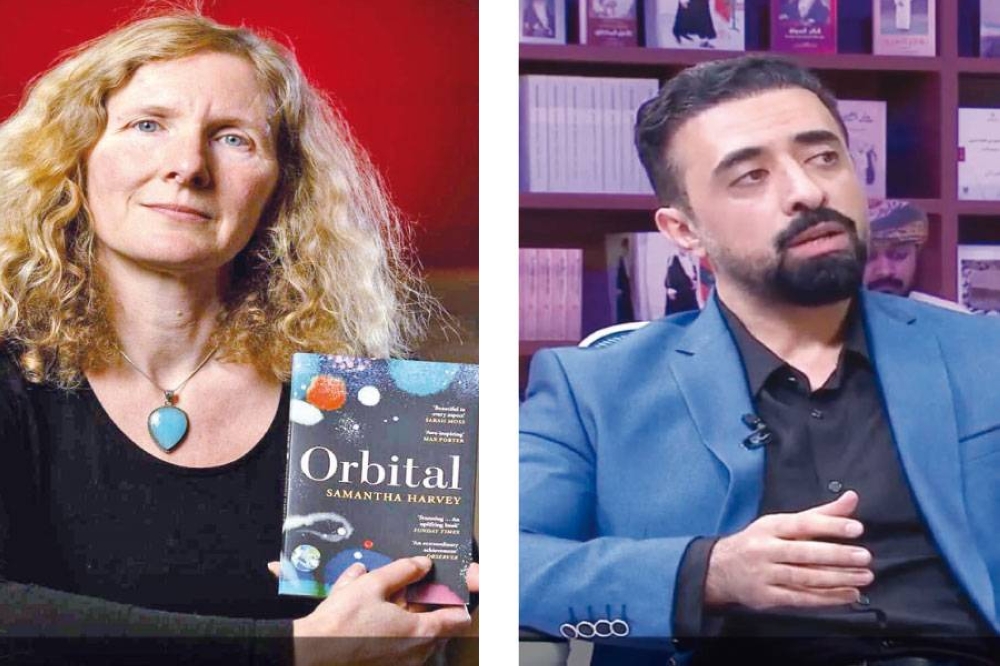عمر خليفة- يقال أحيانا، في معرض النقد الفنّي، إن الفن لا يهدف إلى نقل ما هو واقع فعلا، بل يتجاوز ذلك إلى نقل ما يمكن أن يقع. والفرق بين الواقع وإمكانيّة الواقع كبير جدّا، لأنّك بعد أن تشاهد عملا فنيا ما، قد تحكم بأن أحداث العمل لم تحدث أبدا، لكنك لا تستطيع أن تدعي أنها لا يمكن أن تحدث. ولعلّ جمالية الفن وسحره، إذا ما كان متقنا ومحبوكا، يرجعان إلى هذه الإمكانية التي تنقلك إلى حوادث غريبة تجعلك دائم السؤال عن أسبابها ونتائجها. ولذلك تلقى أفلام التشويق ورواياته نجاحا كبيرا لدى الجمهور، لأنها تلبي رغبة عميقة في النفس الإنسانية، وهي رغبة فلسفية كما يرى أمبرتو إيكو، أساسها أداة السؤال (لماذا)، فهي الوحدة اللغوية التي تتكرر مع كل مشهد درامي، بحثا عن السبب الذي يقود الأحداث في مسارها. ثم يأتي آخر مشاهد العمل، ليكون الجواب، أو اللا جواب، عن هذا السؤال الكبير.
وفي السينما العربية يبرز اسم المخرج الكبير كمال الشيخ، الذي رحل عن عالمنا في بداية العام الحالي، كمثال بارز على مقاربة سينما التشويق وحبس الأنفاس، وهي، ككل مقاربة، يصيبها من النجاح ما يصيبها من الإخفاق. وقد فاجأ كمال الشيخ جمهور السينما في الخمسينيات بباكورة أعماله (المنزل رقم 13) الذي كان مختلفا عن السائد في تلك المرحلة، ومنذ ذلك الفيلم وكمال الشيخ يعمل على أفلام تحاول أن تقول شيئا، لكن الفيلم الذي قال فيه كمال الشيخ قمة إبداعه كان، بحسب كثيرين، فيلمه الخالد (حياة أو موت).
أنتج هذا الفيلم قبل نصف قرن تقريبا، وقام ببطولته عماد حمدي ومديحة يسري ويوسف وهبي وحسين رياض، وطفلة مدهشة اسمها (ضحى أمير)، لا يعرف عنها شيء بعد هذا الفيلم. أحداث الفيلم ليس فيها تميز على المستوى الزمني، فهي تتفق مع الجريان التقليدي للسرد (بداية وصعود إلى الذروة ثم نهاية). تبدأ الأحداث في القاهرة ظهر يوم الوقفة الذي يسبق العيد، حيث يختلف عماد حمدي مع زوجته مديحة يسري خلافا يؤدي إلى خروجها من البيت تاركة زوجها مع ابنته. يحتاج الأب إلى دواء لقلبه فيرسل ابنته لشرائه، لكنها تجد كل الصيدليات في الحي مغلقة (بداية الحبكة)، فتضطر للذهاب بعيدا، وعندما تصل إلى صيدلية حسين رياض يركّب لها الدواء، على عادة تلك الأيام، لكنه يكتشف بعد أن تخرج الطفلة أنه ركّب الدواء خطأ (تصاعد خطير في الأحداث) إلى درجة تؤدي إلى موت من يأخذه.
الفكرة الآن : كيف يمكن للصيدلاني أن يصل إلى الطّفلة التي اشترت الدواء ؟ السؤال يبدو بلا إمكانية جواب، فأنت تتحدث عن آلاف الأطفال الذين يروحون ويجيئون في شوارع القاهرة في ساعات النهار. لكن الفيلم يريد أن يكمل طريقه، فلا بد من طرف خيط، وطرف الخيط هذا هو اسم المريض، الأب، فروشتة الدواء بقيت عند الصيدلاني، وعليها اسم (أحمد إبراهيم). عليه إذن أن يبحث عن هذا (الأحمد). لكن يبدو أن هذا الحل يحتاج إلى حلّ، إذ إن هناك مئات يسمون أحمد إبراهيم في القاهرة. هكذا تبدأ رحلة الحياة والموت في هذا الفيلم. وهي رحلة يشترك فيها الصيدلاني مع الشرطة التي رفضت بداية أن تتجاوب معه لولا أن ضابطا كبيرا (يوسف وهبي) شعر مع الصيدلاني، وأحسّ بمدى تأثره لما سيكون عليه الحال لو وصل الدواء يد المريض. ويجوب الفيلم بنا في شوارع القاهرة بحثا عن الطفلة، يوقفون عربات الميترو أحيانا، ويخرجون كل الأطفال منها، أو يسألون المارّة عن طفلة (تلبس فيونكه) كما هي الجملة الشهيرة في الفيلم.
لكن هذا كله يمضي بلا فائدة، والجانب الآخر من الكاميرا يرينا الطفلة وهي تقترب شيئا فشيئا من بيتها، أو من وفاة أبيها كما يريدنا الفيلم أن نعتقد. لكنّ حلا سحريا يبرز على السطح بصورة مفاجئة، وهو أن تطلب الشرطة من الإذاعة أن تقف عن البث وتذيع بيانا تطلب فيه من (أحمد إبراهيم) ألا يشرب الدواء الذي أرسل ابنته في طلبه. وفي واحد من المشاهد الطريفة في السينما العربية يحدث هذا فعلا، لكن هذا الحل السحري يطرح مشكلة جديدة : كيف سنضمن نحن المشاهدين، الذين صرنا نتمنى أن ينزل وحي على أحمد إبراهيم هذا يحذره من الدواء، كيف سنضمن أن يسمع هو هذا التنبيه والفتاة على وشك الوصول إليه؟
هنا يأتي دور الزوجة (الحردانة)، فبالصدفة نراها تقلب محطات الراديو، فتستمع إلى ذات الإذاعة التي أعلنت الخبر، وعندها تهب راكضة إلى بيت زوجها، فالمسألة مسألة حياة أو موت، كما يخبرنا عنوان الفيلم، ولتذهب الخلافات إلى الجحيم. هي تركض، والطفلة تمشي، والمشاهد يقف على قدميه منتظرا النهاية، ونحن نعلم يقينا أنها ستكون نهاية سعيدة، لكننا، وأتحدث عن نفسي، في حالة ترقب مذهلة، إلى أن تصل الزوجة والطفلة في اللحظة ذاتها، وتكسر الزوجة الدواء الملعون، ويدخل الصيدلاني ورجال الشرطة، وسط ذهول الأب واندهاشه بما يحدث !
حكاية كحكايات ألف ليلة، مليئة بالأسئلة والأجوبة، لكنها تثير في الإنسان مشاعر نبيلة عن الوجود الإنساني وأهميته. وقد رأى بعض النقاد أن من أسباب نجاح الفيلم أنه حاكى العواطف الاجتماعية التي أثارتها ثورة يوليو في تلك الفترة، فهو يبين لنا كيف أن سائر طوائف المجتمع تشاركت في إنقاذ حياة إنسان. وقد استطاع الممثلون نقل هذا المعنى بشفافية، خاصة حسين رياض الذي تشعر مع تعابير وجهه بمدى تخوفه على حياة هذا الإنسان الذي لا يعرفه. ويشار أيضا إلى أن هذا الفيلم كان من أوائل الأفلام العربية التي تصور في الشوارع الحقيقية بعيدا عن الاستديوهات والديكورات، في تأثر واضح بالواقعية الإيطالية التي كانت طاغية في تلك الفترة. وقد أبدعت كاميرا المصور أحمد خورشيد، والد الموسيقار المعروف عمر خورشيد، في تصوير الأماكن وملاحقة الأحداث عبرها إلى درجة تقترب من الوثائقية.
كان كمال الشيخ يرفض أن يقال عنه إنه (هتشكوك الشرق)، في إشارة إلى تأثره بمخرج التشويق الشهير. وهو لم يقتصر فعلا في مدى تاريخه السينمائي الطويل على إبداع أفلام تشويقية، فهو قارب نصوصا إبداعية عديدة من مثل اللص والكلاب وميرامار لنجيب محفوظ، و«الرجل الذي فقد ظله» لفتحي غانم، و«شيء في صدري» لإحسان عبدالقدوس. كما إنه من أوائل من تطرقوا، بعمق، إلى الفيلم السياسي عبر اشتراكه مع كاتب السيناريو آنذاك رأفت الميهي في أفلام مثل «الهارب» و«على من نطلق الرصاص».
يبقى أن نشير إلى حادثة غريبة تؤكد ما قلناه من أن الفن، على غرائبيته أحيانا، يمكن أن يحدث. ففي برنامج وثائقي أعده التلفزيون المصري عن هذا الفيلم ذكر المشاهدون أن حادثة مماثلة وقعت أثناء كأس العالم 1990. فقد توقف التلفزيون المصري عن بث إحدى المباريات ليذيع نبأ طبيا مفاده أن خطأ وقع فيه أحد الأطباء وأنه يرجى من المريض المعني ألا يأخذ الدواء الذي وصف له. وقد سئل الطبيب بعد هذه الحادثة إن كان قد قام بهذا التصرف بوحي من فيلم (حياة أو موت)، فقال إنه شاهد الفيلم، لكنه لم يكن في ذهنه عندما قام بهذا السلوك الغريب !