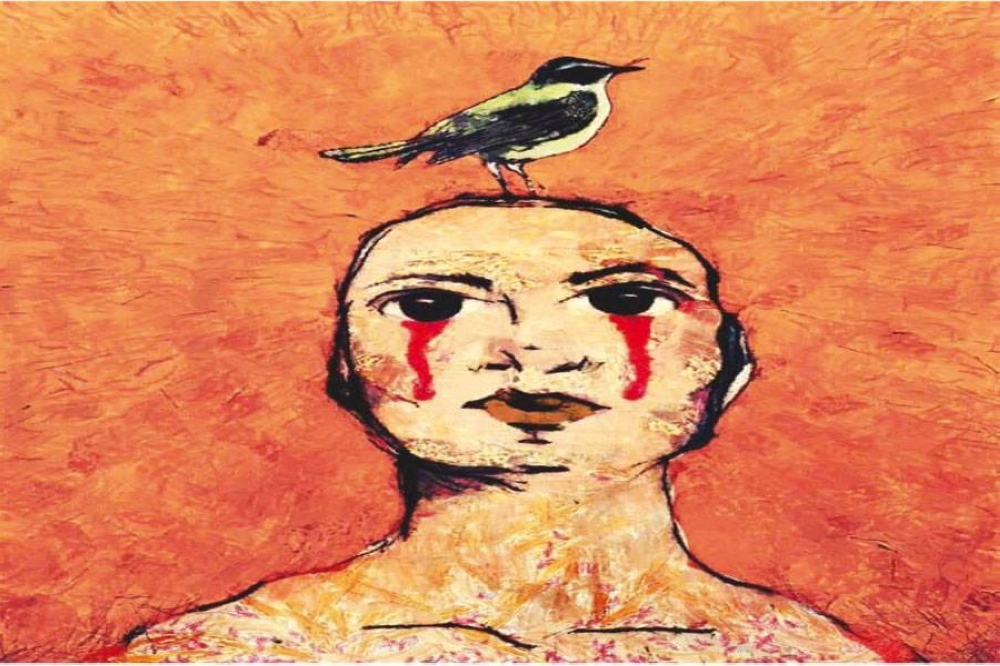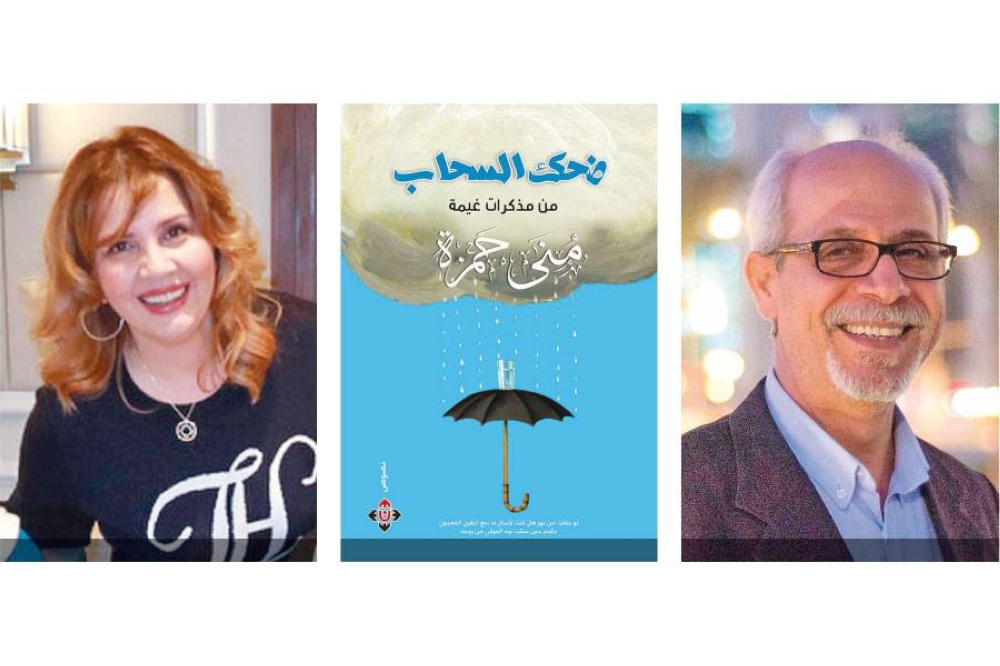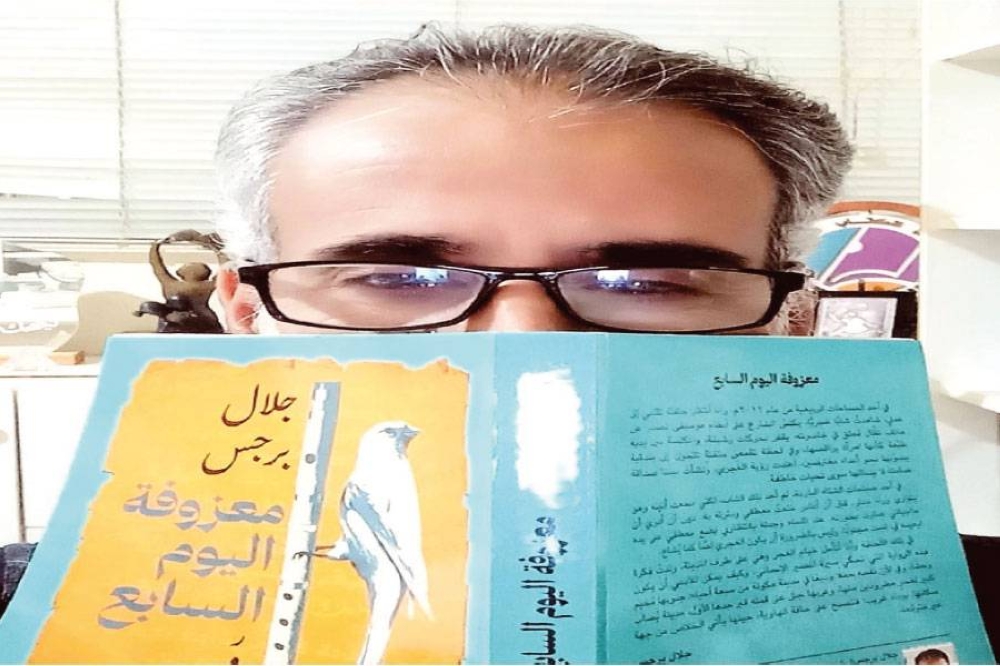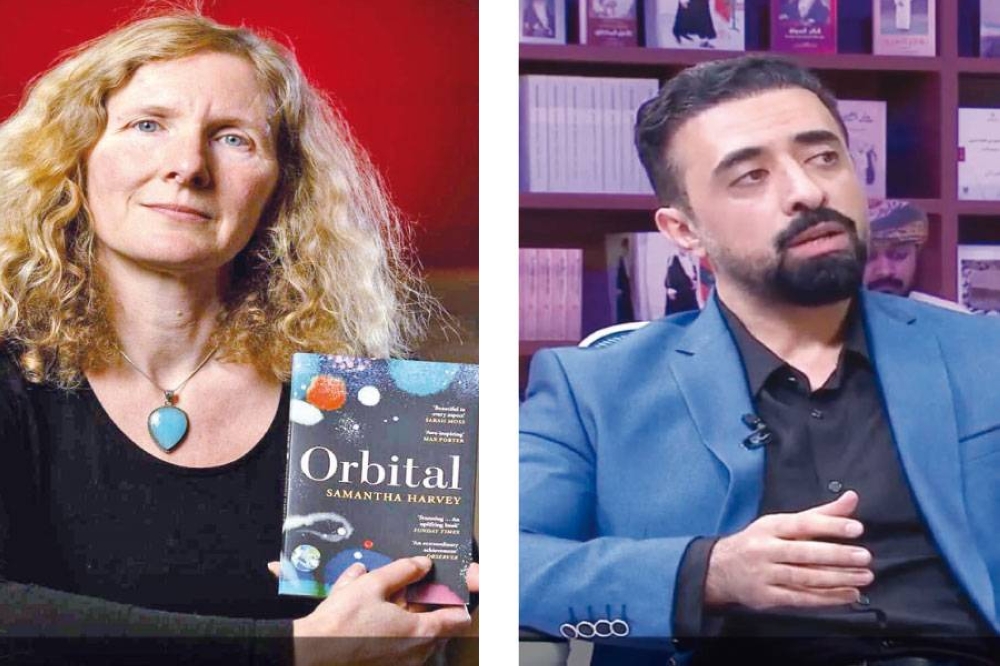تُطلّ قصيدة «يصطاده البحر» للشاعر الأردني علي الفاعوري، من عمق التجربة الإنسانية بوصفها كشفاً شعرياً لانهيار الذات وتحوّلاتها تحت وطأة العجز والضياع، حيث لا تتقدّم الذات باعتبارها فاعلاً حرّاً يُمسك بخيوط مصيره، بل بوصفها كائناً هشّاً، منزوع الإرادة، يُطارَد ولا يطارِد، يُحذَف ولا يُكتَب، وتتناوبه القوى الكونية والزمنية واللغوية كما تتناوب الرياح اتجاهاتها. منذ مستهل القصيدة، تُبنى المعادلة الفنية على فعلٍ مبني للمجهول: «يصطاده البحر»، وكأن الوجود ذاته قد انقلب، فالذات التي اعتادت أن تُمسك بالمقود، أضحت هي?المجداف، بلا شاطئ، وبلا جهة.
في ضوء المنهج البنيوي الفاعلي، تغيب عن الذات الشعرية كل عناصر البرنامج السردي: فلا مرسل يكلّفها، ولا غاية تحدّد مسارها، ولا وسيلة تعينها، ولا جهة تناديها. إنها ذات مقذوفة في فراغ سردي، تُسيّرها قوى خارجة عن إرادتها، دون قدرة على الإيقاف أو الرجوع. تتبدّى هذه الذات عبر أفعال مفعولية: «تُجذفه الدنيا»، «تقطفه الريح»، «تُحذف أحرفه»، بما يُحوّل بنيتها من فاعلية إيجابية إلى حالة من الانسحاب المتكرر، في نصٍّ يُفكك ذاته من الداخل، ويُعيد إنتاج الشخصية لا بوصفها متكلماً، بل بوصفها أثراً لغويّاً لا يكاد يُثبت وجوده ?بل أن يتلاشى.
هذا الانقلاب البنيوي يجد صداه في التفكيك، الذي يُظهر اللغة لا بوصفها حاملاً موثوقاً للمعنى، بل كمجال مُهدّد بالتآكل، ومشبوهٍ في ثباته. اللغة في هذه القصيدة ليست وسيلة للبناء، بل وعاء مثقوب، تسقط منه الأحرف، وتذوب فيه الأسماء قبل أن تستقر. «اللغة الخضراء» التي تسقط من يده، ليست فقداً لجمالية لفظية فحسب، بل انهياراً للرمز نفسه، وموتاً لمركز الذات داخل النظام الدلالي. في كل مرة تحاول الذات أن تُدوّن نفسها، يُباغتها «خريف غريب الوجه»، فيلغي حضورها. هذه اللغة التي تتآكل وتُحذف وتفقد القدرة على الإحالة، تُعيد تش?يل الذات كصوتٍ غير مكتمل، ككلمةٍ تموت قبل أن تُقال.
لكن ما يتجاوز هذا البُعد البنيوي والتفكيكي هو انفتاح النص على قراءة وجودية ترى في هذا التيه الشعري تمثيلاً لكينونة مأزومة في عالم عبثي، لا يمنحها معنى ولا يحتضن غربتها. فليس هناك وطن تستقر عند بابه، ولا درب يحملها إلى جهة، ولا حلم يُطلّ إلا على صفعة الواقع. الذات الشاعرة تائهة بين فقد الهوية وفقد المعنى، تتقدّم في الزمن لا نحو مستقبل، بل نحو انهيار داخلي صامت. القصيدة في هذا السياق تُجسّد ما يسمّيه سارتر: «القلق الوجودي»، حيث يصبح الإنسان مشروعاً مفتوحاً على اللاشيء، ويحمل عبء تشكيل نفسه في عالم لا يعترف ب?، ولا يعينه على حمل عبئه.
وبالتوازي، تنفتح القصيدة على أفق صوفي مشبع بالرموز والدلالات، يُحرّكها الشوق نحو مطلقٍ لا يُدرك، ولا يُوصَف، بل يُلمَح في وجع التجربة. البحر، الذي يصطاد الذات، يُستعاد هنا كتمثيل للسرّ الإلهي، الذي يبتلع العاشق لا ليُهلكه، بل ليُذوّبه في مداه. «الناي» و"العشّاق» و"اللغة الخضراء» ليست مفردات زينة، بل أبواب للمجاهدة، وصدى للفقد الذي لا يُشفى منه إلا بالفناء. وعند «تلبّسته وطفل الجن يصحبها»، نصل إلى قمّة الانخطاف، حيث تُغادر الذات وعيها لتدخل في طور الحلول الرمزي، وتتحوّل الرؤيا إلى نبوءة، والقصيدة إلى مقام و?ودي تتجلّى فيه الذات وهي تُجَرَّد من كل قيد. غير أن هذا الفناء الصوفي لا يبلغ بهجة الوصال، بل يحتدم في لحظة الاحتراق، حين يتحوّل «التصوّف» ذاته إلى «آخر قتلاها»، في مشهد يُعلن أن الحضور في المطلق قد يكون أكثر فتكاً من الغياب.
تتداخل هذه القراءات الثلاث: البنيوية، والتفكيكية، والوجودية-الصوفية، لتُبرز القصيدة كنسيجٍ شعريٍّ محكم، يُعيد تشكيل التجربة لا بوصفها سرداً، بل بوصفها نبضاً داخلياً يتكسّر على صخور اللغة. وهذا لا يتحقق إلا بفضل براعة فنية عالية، يملك فيها الشاعر أدوات لغوية تمكّنه من إعادة تشكيل المجاز، واختراع صورة جديدة للذات وللعالم. الصور في النص ليست تجميلاً، بل بنى دلالية تُؤسس لعمق النص: «القصائد أسراه»، «اللغة تسقط»، «التصوف قتله»، «الخريف يحذفه»... كلها ليست مشاهد بل مآلات، تُسهم في تحريك المعنى نحو غاياته القصوى.
تنجح القصيدة فنياً لأنها لا تصف التمزق، بل تجسّده. لا تروي الحزن، بل تُصبح هي ذاتها حزناً لغوياً حيّاً. لا تقول الذات «أنا ضائعة»، بل تبني نصاً تتوه فيه اللغة نفسها، وتفقد الأفعال مرجعها، وتتحوّل القصيدة إلى قيد وجودي لا مخرج منه. لهذا، فإن الشاعر لا يقف خارج التجربة، بل يُلقي بنفسه في عين العاصفة، ويكتب من قلب الاحتراق، ويبلغ بالقصيدة حدّها الأقصى، حيث لا يبقى منها إلا ظلٌّ يمضي في المجهول، لا جهة تصرفه، ولا اسمٌ يكتبه.