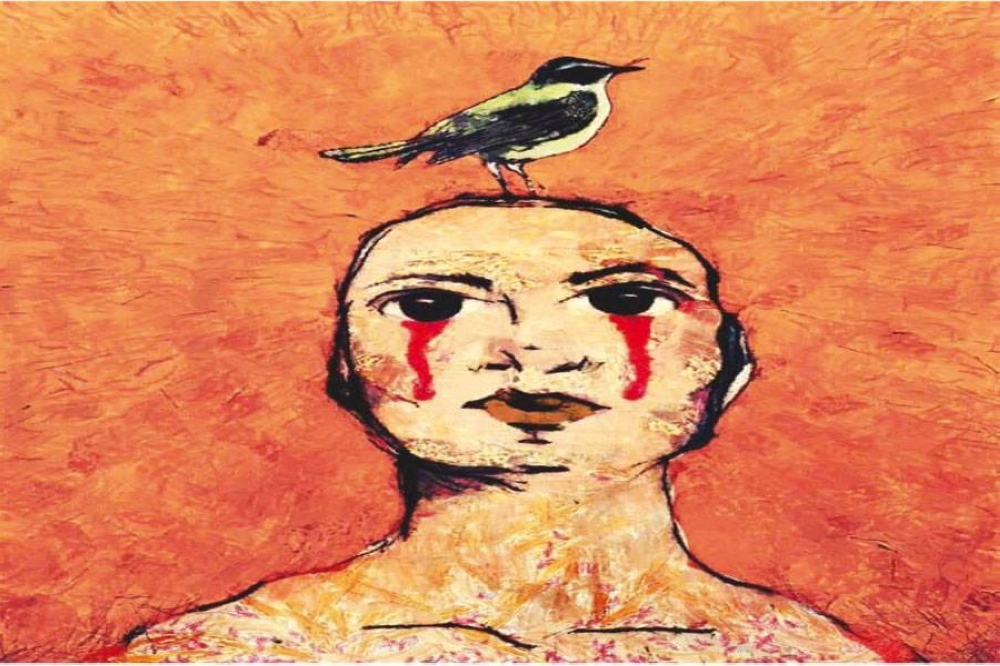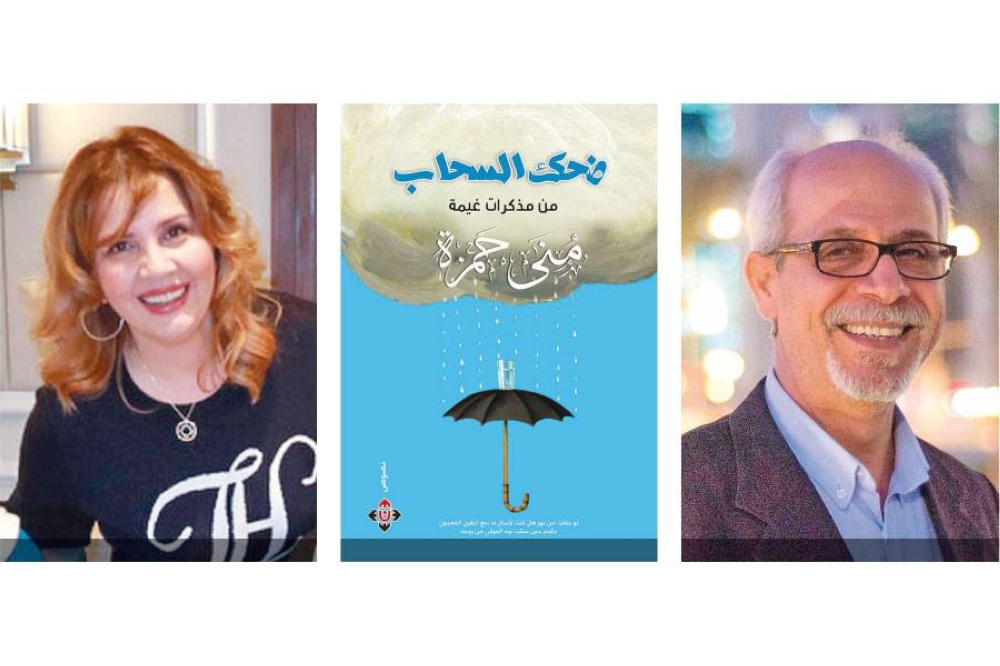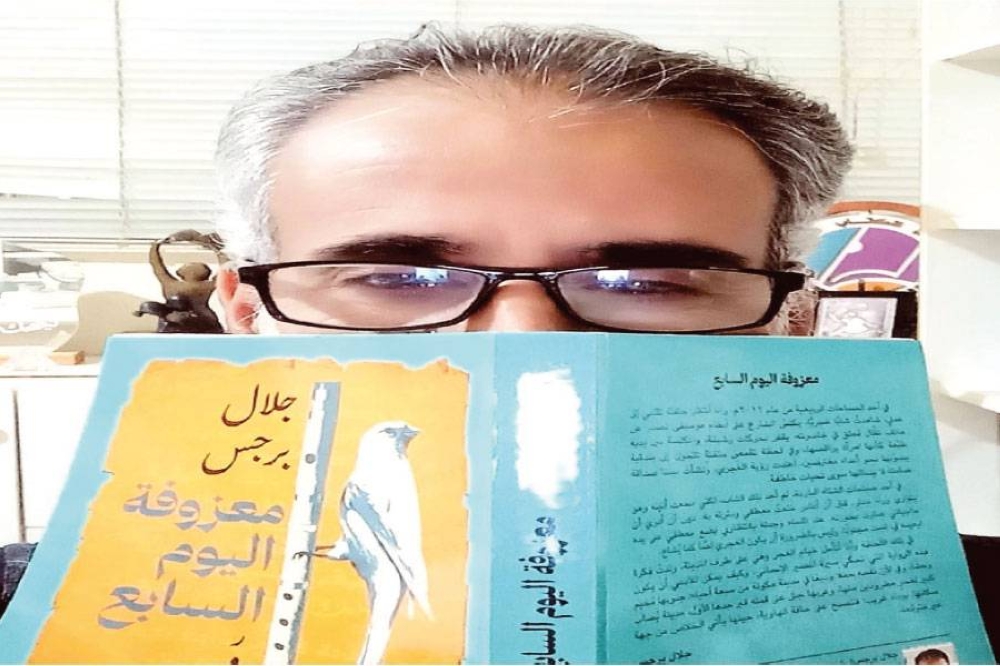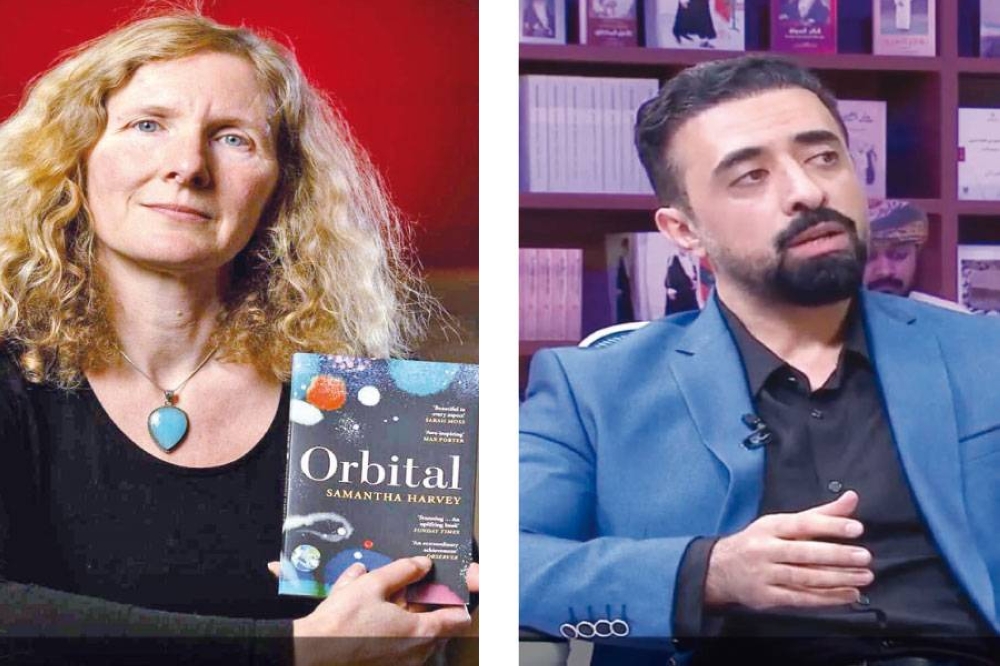الناظرُ إلى اللغة العربية يعي نزوعَ النحاة في عللهم إلى الخفّة، «ولا أدلّ على ذلك من تلك العبارة الشّهيرة «مَنعَ من ظهورها الثّقل» فالبحث عن علل النحو مبنيّ على أساس من الأسس التي بُني عليها كلام العرب، وهو التماس الخفّة، وتجنب الثّقل"(1).
ولما كان الروائي الراحل مؤنس الرزاز يقتفي في روايته «جمعة القفاري» أثرَ الخفّةِ أينما وجدتْ؛ فجعل ينزع عن بطل روايته ثقل الظهور واكتفى بعنوانه الفرعي «يوميات نكرة»، وعندما حاول لاحقاً التعريف به، آب إلى الاقتصاد اللغوي عند النحاة بقوله: «نعم. أنا جمعة القفاري (ما غيره) الذي عاش طوال حياته في عمان الغربية... نعم، أنا نكرة"(2)، ورغم تكرار جملة التعريف، إلا أنها كانت دوماً ترتبط بتحرر الذات وخفتها أمام ثقل الحياة؛ لندخل حيز الفلسفة وسؤال الخفّة الوجوديّة الذي طرحه ميلان كونديرا عبر روايته «كائن لا تحتمل خفته».
يقول مؤنس: «نعم أنا جمعة القفاري، أسند خدي بباطن كفي وأفكر في كتابة رواية... وأنا جمعة القفاري الذي أحب المغامرات ولم يخض في لجتها... نعم. أنا جمعة القفاري الذي لا يعرف سعر علبة السمنة أو كيلو اللحم... نعم. أنا جمعة القفاري دون كيشوط هذا العصر... نعم. أنا جمعة القفاري، النكرة في عصر لم يعد فيه عمالقة» (3). وبذا يقوم بحثنا على التماس الإجابة عن سؤال الخفّة الوجوديّة والثّقل في الرواية.
في التمثيل على الخفّة الوجوديّة
أولاً: يعدّ فعل الكتابة تأجيلاً للمصير، وربما يكون رفضاً ضمنياً لثقل فناء الجسد بواسطة الموت، فيسعى الكاتب لتخليد الروح بأشكالٍ إبداعية. ولا نتحدث فقط عن مؤنس إذ يكتب روايته تحقيقاً لذلك؛ بل إن الكاتب جعل من جمعة القفاري يحرز خفّةً مُضاعفة، عبر كتابة رواية بعنوان: «مغامرات النعمان في عمان».
ثانياً: التخفف من عباءة الثقافة الغربية التي أثقلت الواقع العربي، وجعلت من المثقف مندهشاً بها وجاهلاً بثقافته القومية، ورفض كل أشكال الاستعمار ومخلفاته، من خلال التمثيل بشخصياتٍ عربية ومحليّة ونقش أسمائهم على جدار وعي القارئ؛ يقول عن أديب الدسوقي وصورة البطل العربي: «أما لماذا لا يركز الإعلام الغربي على بطل الأردن الأسطورة، فلأنه إعلام يسيطر عليه الصهاينة. هكذا كانت أيام أحمد سعيد وصوت العرب وتمساح النيل وأبو هيف وأبطال الزمالك. نعم. أبطال نادي الزمالك المصري كانوا أبطالنا. أبطال العرب» (4).
ثالثاً: التحرر من النمطيّة وكسر قالب المثقف المثقل بالتقليد- وأوصافي هذه لا ترقى لخفّة مؤنس في تندّره على صاحب محل الفيديو، أثناء وصفه العروس: «هذا ولد أحمق. إنّ أمثلته لا تمت إلى العصر بصلة. (امرأة مثل وردة!).. عبارة مبتذلة لا يقولها مثقف على مشارف القرن الحادي والعشرين. لكن من يحمل وجهاً مثل وجه صاحب محل الفيديو هذا لا بد أن يستخدم مفردات غبية سوقية كهذه» (5).
رابعاً: السخرية، والتي يعمد إليها المؤلف لخلق واقعٍ بديل يُعادل الواقع المُعاش، وتهيئ للقارئ عالماً آخر مُتخيلاً بإزاء عالم الرواية العام، مما يسهم بتخطي الأخير، وتتويج المعادل الموضوعي الساخر. وهو ما كشفه مؤنس في أحد حواراته: «السخرية السوداء خير سلاح لمواجهة فجائع الواقع المعاش، الخاسر الذي يضحك من جراحه منتصر في حقيقة الأمر، والمهزوم الذي يضحك من هزائمه هو الرابح الأكبر» (6). وفي مورد مقابلة سخريته بسخرية والده د.منيف الرزاز، يقول: «سخرية منيف الرزاز أقرب إلى الكاريكاتير اللاسع المرح، أما سخريتي فمضمرةٌ ومرة، سخريته بيضاء، وسخريتي سوداء، ربما منيف الرزاز لم يعرف الكآبة، بينما عرفتني الكآبة مبكراً» (7). باتت الكوميديا السوداء ملاذاً لدرء عبء الوجود، ومواجهة كآبة الذات؛ برشّ الملح على جرحها وتعريتها؛ وهذا لعمري عين الخفّة.
خامساً: الكشف عن الأسرار (جمعة يكشف سراً من أسراره!):
"كنت مثل (بائع خضرة) في سوق الخضار: عندي اكتئاب وإدمان وأرق ونقص مروع في القدرة على التأقلم والتكيف وصعوبة في (إنتاج) الأصدقاء، وعسر في التعبير عن الذات، وزكام متصل، وشعور غامض بالخطر، وإحساس بأن شبح الموت يحوم حولي» (8). يرتبط مقام الكشف بكينونة الروح، فنجد إزاحة الستر عنها سبيلاً لاجتناب تكديس الأثقال المذكورة آنفاً؛ اكتئاب، إدمان، أرق..
سادساً: العلاقة بين جمعة القفاري وابن عمه فاضل القفاري، المعروف بـ «كثير الغلبة» أو «الغلباوي». واللمسات الخفيفة التي يضفيها الأخير على لوحة جمعة المُعتمة، ووعي جمعة بأنّه «يغض الطرف عن بعض تصرفات كثير الغلبة ويقبلها على مضض، لمعرفته أنه بحاجة دائمة إليه» (9). والعلاقة مع أخته عائشة التي «يعتمد عليها كلياً في كل تفاصيل حياته» (10).
سابعاً: وكما عبّر عنه د.غسان إسماعيل عبد الخالق؛ «إن تجربة مؤنس الرزاز هي المؤشر الحاسم على تحطّم بنية الرواية التقليدية في الأردن» (11)، لينهض من رماد أشكال الكتابة الروائية، متجدداً «يعمد إلى المعمار المعقّد للسرد، وتصبح تقنية تعدد الرواة وزوايا النظر حجر الأساس في كتابته الروائية» (12).
•في التمثيل على الثّقل
يكفينا المؤونة أن نذكر ما انزوى عليه البُعد الآخر/ القراءة التأويلية لتمثلات الخفّة المرجوة؛ ففي الوقت الذي كتب فيه مؤنس الرزاز روايته «جمعة القفاري»، وحاول القفاري بدوره كتابة روايته «مغامرات النعمان في عمان"؛ نواجه اعترافات من نوعٍ ثقيل، يفشي الكاتب من خلالها أنه «يروي ببساطة قصة تاريخه المرضي وعلاجه عند الدكتور تونكس في لندن أو عند مشايخ التصوف في عمان، وكلا الاعترافين مسجلين في سيرته الجوانية في مجلة (أفكار)، ومبكراً في روايته جمعة القفاري» (13) والتي جاء فيها: «ثم أُدخل جمعة إلى مصح للأمراض النفسية والعصبية، في بلاد بعيدة طبعاً، فهو ابن أسرة محافظة لا ترغب في الفضائح، ولا تعتبر نشر غسيلها الداخلي من هواياتها المفضلة!» (14)، كما لم يقيض النجاح لجمعة فخرج «من مشفى الشميساني للولادة، دون أن ينجب فكرة واحدة تصلح لإنجاز روايته» (15)؛ ليمحو ما وصفناه بـ"الخفة المُضاعفة»، بثقلٍ مزدوج!
يضاف إلى ذلك الثقل؛ اغتراب جمعة المثقف عن واقعه، و"قبوله لتوصيف (دون كيشوت) وإصرار الآخرين على استخدامه، تأكيداً على استلاب الغرب لذاكرة المشرق، الذاكرة التي ينبغي أن تمر عبر ذاكرة الآخر لتستعيد هويتها» (16)، وتكراره ثلاثاً: «هل هذا العالم عصي على فهم كل الناس أم أنه عصي على فهمي أنا فقط؟»، «لا أفهم هذا العالم»، «اجتاحه إحساس بأن هذا العالم معقّد جداً ويأبى على الفهم» (17)، ناهيك عن «اغتراب جمعة القفاري، في البعد النفسي (الذاتي)، فهو شخصية اعتمادية... وشعوره بالعجز تجاه التكنولوجيا» (18).
أما السخرية مهما حاولنا تخفيف سوداويتها، فما زالت كوميديا سوداء. «يحب مؤنس أن يبكي وهو يضحك، وأن يضحك وهو يبكي» (19). وفي بحثنا عن جمعة يذيع أسراره، فيسلط الضوء عليها كاشفاً سترها، فإنما المستور منها أو المتكشف لا يلغي رجحان كفتها في ميزان الثقل؛ اكتئاب وإدمان وأرق، وتساؤلات لا تنتهي: «هل يرجع سبب الاكتئاب الحاد المتصل إلى عدم التأقلم؟ أم أن عدم القدرة على التأقلم يعود أصلاً إلى الاكتئاب؟ وهل يكمن سبب إدمانه في حساسيته المفرطة؟ أم أن حساسيته المفرطة ما هي سوى نتيجة للإدمان؟» (20).
وصولاً إلى ابن عمه، الذي كان يراوح في ألقابه أثناء الحديث عنه: «الغلباوي/ كثير الغلبة»، وأفرد له فصولاً متتالية كتمهيدٍ لتبدل حاله، مما جاء على لسانه: «قلت أنني أرغب في الوصول، وأنني لست شخصية سوداوية زاهدة غبية مثل جمعة القفاري» (21)، وفي موطن آخر: «بدأ نجمي يلمع في الصحافة. قلت لجمعة القفاري ناصحاً: انصرف عن الأدب والحكي الفاضي، وتعال إلى عالم الإعلام. وكشفت له عن سر خطير حين قلت له إن سر نجاحي هو النفاق على الخفيف، وإسماع المسؤول ما يحب أن يسمع» (22). هذه المآل لشخصية ابن عمه كمثقفٍ شغلته الأضواء، جردته من تلك الألقاب المحببة التي أضفاها عليه جمعة بدايةً؛ ليصير فاضل القفاري حاف! وبتصريحٍ لسأمه من جمعة القفاري، تأتي قاصمة الظهر «أنه مل وتعب من لعب دور ولي أمره» (23)، في حين لم تتوانَ عائشة في تمثل الثقل بهيئة الغياب، «ولم تفِ بوعدها، فمضت إلى زوجها في الخليج» (24).
وفي جانب «تحرره التام من عقدة السرد الأفقي للأحداث» (25) وميله إلى التجريب، وتحطيم بنية الرواية التقليدية في الأردن -كما أشرنا سابقاً- نجده في حوارٍ أقرب إلى البوح والفضفضة، يخبر بحال النقاد في «تغطية الجانب السياسي الأسهل في رواياته، لكنهم في الغالب الأعم قصروا في رؤية تأثير الأحداث السياسية على سيكولوجية أبطالي بشكل عام» (26).
تساوت كفتا معادلة الخفّة الوجوديّة والثقل كيفما وجهها الباحث، لكن ما زال الحسم بينهما يستدعي تدارك مسألتي: النهاية والحب. ففي معالجة الأولى؛ تحجب العتمة الغامضة الحارة، ويغيب جمعة في سيارة الشرطة منتظراً مقابلة المخرج الذي سيعلن أخيراً، انتهاء أدوار جمعة المؤلمة. وفي معالجة الثانية؛ يرفض جمعة الحب، لأن حب «امرأة من لحم ودم، يفسد الحلم»، فالحب هزيمة» (27).
ختاماً، حاولنا الإلمام بمحاولات مؤنس الرزاز للتخفف من ثقل الظهور، على طريقة النحاة العرب في اقتصادهم اللغوي. وذهبنا إلى أبعد من ذلك فطرقنا باب الفلسفة الغربية، أعني ميلان كونديرا في سؤال خفته الوجوديّة، لكن الأثقال كانت بالمرصاد لجمعة القفاري، ومن قبله كونديرا، وللأدب من بعده: بخسارته.
* المراجع:
(1) هادية رواق، مبدأ الاقتصاد اللغوي في الاستعمال العربي (منزع الخفة واجتناب الثقل نموذجاً)، بحث، مجلة العلوم الاجتماعية، اللغة العربية، اللغويات، 2017.
(2) مؤنس الرزاز، جمعة القفاري (يوميات نكرة)، رواية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، 1990، ص5.
(3) مؤنس الرزاز، جمعة القفاري، مرجع سابق، ص7.
(4) مؤنس الرزاز، جمعة القفاري، السابق، ص6.
(5) مؤنس الرزاز، جمعة القفاري، السابق، ص39.
(6) هاملت عربي، مؤنس الرزاز: شهادات وحوارات ودراسات، عبد الرحمن منيف وآخرون/ مؤلفون عرب، مركز الرأي للدراسات والأبحاث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، 2003، حاوره: هاشم غرايبة، ص20.
(7) هاملت عربي، السابق نفسه، ص21.
(8) مؤنس الرزاز، جمعة القفاري، مرجع سابق، ص20.
(9) مؤنس الرزاز، جمعة القفاري، السابق نفسه، ص96.
(10) مؤنس الرزاز، جمعة القفاري، ص154.
(11) د.غسان إسماعيل عبد الخالق، الأعرابي التائه: مقاربات في تجربة مؤنس الرزاز الروائية، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، أمانة عمّان الكبرى- مديرية الثقافة، ص15.
(12) رابطة الكتّاب الأردنيين، مؤنس الرزاز وعبد الرحمن منيف، وزارة الثقافة، ط1، 2005، عن تجربة مؤنس الرزاز الروائية وأطروحة الانهيار، فخري صالح، ص38.
(13) مؤنس الرزاز: ريادة إبداعية، مجلة أفكار، وزارة الثقافة، نيسان 2002، العدد 163، سيرة روائية؛ عن مؤنس الرزاز الذي مات قبل أن يحيا، نزيه أبو نضال، ص26.
(14) مؤنس الرزاز، جمعة القفاري، مرجع سابق، ص20.
(15) مؤنس الرزاز، جمعة القفاري، ص142.
(16) د.غسان عبد الخالق، الأعرابي التائه، مرجع سابق، ص39.
(17) مؤنس الرزاز، جمعة القفاري، ص51 و81 و131.
(18) آلاء يوسف عطاالله الظاهر الشّمري، أزمة المثقف في روايات مؤنس الرزاز، رسالة ماجستير، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، 2011، الاغتراب.. وجهاً آخر لأزمة المثقف، ص115.
(19) مؤنس الرزاز: ريادة إبداعية، مجلة أفكار، مرجع سابق، مؤنس الرزاز عن بعد!، د.غسان عبد الخالق، ص48.
(20) مؤنس الرزاز، جمعة القفاري، ص20.
(21) مؤنس الرزاز، جمعة القفاري، ص156.
(22) السابق، ص179.
(23) السابق، ص209.
(24) السابق، ص213.
(25) د.غسان عبد الخالق، الأعرابي التائه، مرجع سابق، ص19.
(26) هاملت عربي، السابق نفسه، ص22.
(27) مؤنس الرزاز، جمعة القفاري، ص5.