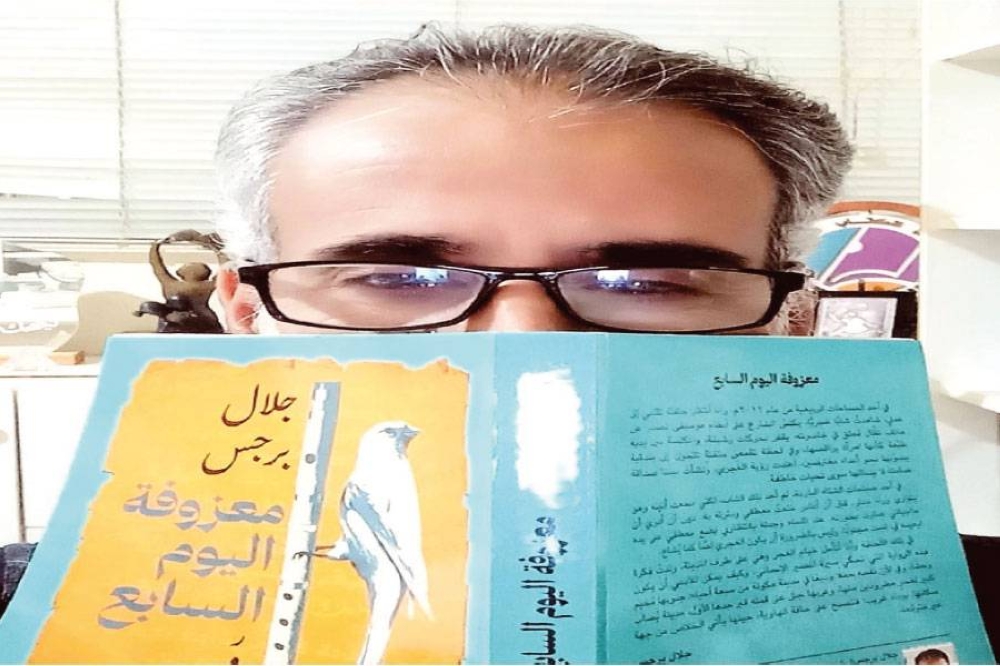الزمان: آخر لحظات نهار قصير صادف يوم المرأة العالمي.
المكان: غرفة أنيقة في أحد المنازل الفخمة، تجلس في إحدى زواياها امرأة جذابة رشيقة جميلة الوجه والثياب. تمسك هاتفها النقال وتلتقط لنفسها صورة عن قرب وهي جالسة خلف كرسي مكتب وثير وأمامها تقويم يشير إلى تاريخ الثامن من آذار. أمامها جهاز حاسوب مفتوح على صفحة ملف فارغة تتنتظر من يغنيها بالكلمات. وما إن تفرغ المرأة من تصوير نفسها، تحدث ذاتها بصوت مرتفع وتقول:
كل عام وأنا بخير. اليوم يحتفل العالم بي وبكل النساء. أريد أن أتوج هذه المناسبة بكتابة مذكراتي. سأبدأ بما حدث معي يوم أمس. أريد لمذكراتي أن تكون صادقة. لن أزينها بالمثاليات. سأكون وفية للصدق وأنا أعود بذاكرتي الى الوراء.
في الأمس كنت برفقة زوجي في ندوة تضم مجموعة من المثقفات والمثقفين لنحتفي بيوم المرأة العالمي. صدمتني طريقة احتفال المرأة بذاتها. كنت أجلس وزوجي في الصفوف الأمامية تجنباً للضجيج الذي تحدثه بعض الحاضرات وبعض الحاضرين لمثل هذه الندوات حين يختارون الجلوس في المقاعد الخلفية. ولم يسعفني اختياري للمقعد المتقدم في النجاة من تعليقات إحداهن السلبية الممتلئة حقدا ونقمة على كل شيء، وربما على الوجود!
سمعتها تحدث رفيقتها الجالسة بجانبها عن إحدى الكاتبات التي قدمت ورقة عمل يوم الأول من أمس:
• لقد كانت ورقة سخيفة.
• حقاً؟ لحسن حظي لم أكن موجودة.
• فعلاً أتدرين لقد كانت ورقتها عن أهمية وجوب كون المرأة لطيفة. سيدتي. عليك أن تكوني لطيفة دائماً ... لا تنسي أبداً أنك أنثى.
• ها ... ها ... ها... ها ... ها.
• صدقيني هذا ما قالته، وكأنها تتحدث على صفحات إحدى المجلات أو تخاطب المستمعات عبر الإذاعة.
• يا للسخف، إنهم ينشرون لها مقالاتها وقصصها في الجرائد. حظوظ.
• تخيلي، لقد أحضرت والدتها معها إلى الندوة لكي تراها وهي تلقي الورقة.
• وهل فهمت والدتها شيئاً مما تقوله؟
• ها ... ها ... ها ... ها.... ها... بالطبع لم تفهم شيئاً، لقد طلبت مني أن أُجلس والدتها بجانبي حتى أعتني بها. فأجلستها على الكرسي المجاور لي، ورأيتها تتأمل ابنتها بإعجاب. مسكينة.. امرأة جاهلة.
• طبعاً، أم الكاتبة العظيمة!
• لقد قلتُ لابنتي كاتيا أن تحضر معي الليلة إلى هذه الندوة فرفضت.
• ولماذا، ألا تحب حضور الندوات الثقافية؟
• لا، إنها تقول: هل تريدين مني أن أذهب لسماع «المعقّدات».. ها ... ها..... ها..... ها.
• معها حق ... ها ... ها ... ها.... ها.... ها.
حينذاك شعرتُ بغثيان مفاجئ ينتابني. ما هذا الذي أسمعه! هل هذه هي المرأة التي نلتقي في الندوات لنحتفل بيومها العالمي؟!
أف ... متى ستبدأ هذه الندوة حتى تصمت هذه المجموعة من المثقفات الجالسات خلفنا. ولم يطل انتظارنا، فقد باشرت مديرة الحوار بالتعريف: الكاتبة والشاعرة فلانة المناضلة للدفاع عن حقوق المرأة، الدكتور فلان المهتم بشؤون المرأة، والأستاذة فلانة التي تسعى لتغيير القوانين لصالح المرأة. الدكتور يرى بأن الأعراف والتقاليد هما السبب في غياب بعض حقوق المرأة. والكاتبة الشاعرة تؤيد هذا الرأي بشدة وتطالب المرأة بأن تثور على الوضع، أما الأستاذة فترى بأن التقاليد فقط هي السبب والقانون بإمكانه تغيير الوضع وقلبه رأساً على عقب.
أما الحضور فقد أتيح لهم أن يتحدثوا وأن يناقشوا بعض النقاط. أعجبني قول أحد الحاضرين: أنتم تطالبون بمساواة المرأة بالرجل، المهم أن نصل إلى مساواة الإنسان بأخيه الإنسان بدون التفريق بين رجل وامرأة، الإنسان بصورته المجردة هو الأهم.
آه... يا إنساان!
عدت إلى النظر خلفي فرأيت أم الفتاة التي ترفض حضور الندوات النسائية لأنها لا تحب الاستماع إلى «المعقّدات»، رأيتها تخترق الصفوف لتقف أمام الميكروفون فتدافع بحماس شديد عن المرأة ومكانتها وحقوقها. سمعتها تؤيد وتفند وتقول كلاماً كبيراً كبيراً كاد يخترق جدران القاعة.
كلامها ألهب حماس الحضور فصفّقوا لها بشدة. معذورون.. لم يسمعوا مثلي ما كانت تحدّث به رفيقتها قبل بدء الندوة. إنهم لا يدرون التناقض الغريب بين ما تقوله أمامهم وبين ما غرسته في ذهن ابنتها.
آه ... يا إنسان! مسكينة أيتها المرأة، تريدين الارتقاء بمكانتك وتهينين ذاتك في الوقت نفسه.
عادت المتحدثة «الرائعة» إلى مقعدها وهي فخورة بما نالته من إعجاب. لا بد أنها ستحدث ابنتها عن هذا النجاح الباهر، فحديثها كان «أفضل» من حديث كل المتحاورين والمتحاورات في الندوة. لقد «أجادت»، ويحق لمن كانت مثلها من البنات أن تفخر بأمها «غير المعقّدة!
بدأ الغثيان ينتابني من جديد. فطلبت من زوجي أن يعطيني «ملبّسة"؛ فتناولت من يده «ملبّسة» أنستني حلاوتها مرارة النفاق الذي شهدته قبل قليل. تابعت الندوة حتى النهاية. صفّقت للمنتدين لأنهم تمكنوا من توضيح ما كانوا يريدون قوله، وقد أجادوا فعلاً فيما قدموه.
وعند باب القاعة ونحن نغادر سمعت صديقتنا «غير المعقّدة» تقول:
"ما هذا السخف. من أين أتوا لنا بمديرة الندوة هذه!؟ أف.. أف.. أف.. يبدو أنها تعتقد أنها تجلس بين جاراتها في المطبخ!».
لم يعد بإمكاني أن أحتمل سماع المزيد من هذا الكلام، فأمسكت بذراع زوجي وسارعنا الخطى إلى خارج المبنى، وما هي إلا لحظات حتى احتوتنا نسمات المساء النقية وغمرتني واياه بطهر السماء.
هل يحق للمرأة أن تسف ه ذاتها؟!
كيف لي أن أفخر بكوني أمراة مثقفة وأنا أرى زميلاتي يغرزن السكاكين في نحور بعضهن؟
سأكتب عما حدث في الندوة في مذكراتي ولن أنزع حرفا من مجرياتها. أريد أن أبقى شفافة نقية بصدقي مع ذاتي ومع الآخرين.
وسأكتب أيضا عما رأيته في مدرج المسرح خلال عرض المسرحية التي حضرناها أنا وزوجي يوم أمس برفقة أصدقاء دعونا لحضورها بعد انتهاء الندوة الخاصة بيوم المرأة العالمي.
هنا أيضا، على المسرح، كان الحوار سلسا، ممتعاً، شيقاً.. كل شيء يدور بسلاسة وفق تخطيط مسبق. خلافات مدروسة تدور بحدة، ولين أيضاً، بين الممثلين والممثلات. تكررت كلمة «القمع» عشرات المرات وكانت كلما خرجت تدفعني رغماً عني لمتابعة الأحاديث الجانبية الدائرة بين الجالسات خلفنا في الصف الثاني للمسرح، فكنت أنظر بدون إرادتي إلى ثيابهن. إحداهن كانت ترتدي تنوره قصيرة جداً.. جداً.. أخرى كانت ترتدي بنطالا ضيقاً جداً.. جداً.. جداً. وغيرهما كن يرتدين فساتين مكشوفة الصدر جدا.. جدا.. جدا.. جدا..
يبدو أنني، وهذا من حسن حظ زوجي بالتأكيد، ما زلت متخلفة عن ركب الموضة الدارجة لدى البعض في هذه الأيام، فليس بمقدوري أن أخرج من المنزل بمثل هذه الثياب إلى مكان عام. هل سأتغير في يوم ما؟ ربما، لكنني أتمنى ألا يحدث ذلك. فالعري المقنع لا يستهويني.
نعم، أحب الاحتشام في كل شيء، خصوصا في القول والملبس.
بعض صديقاتي يقلن أنني معقدة، ولكنهن مخطئات. ليس الاحتشام تعقيدا، بل هو احترام للجسد الذي هو معبد الروح. أحاول بشتى الوسائل أن أحافظ على معبدي. فالله يقيم في قلبي ومشاعري وأسعى دائما لكي أبقيه راضيا عني.
سأكتب هذا في مذكراتي، وسأكتب أيضا عن عتبي الشديد على صديقتي عنود التي أصبحت مسؤولة عني في العمل. كانت قبل ذلك تحتسي القهوة معي في مكتبي ونتبادل الزيارات والأسرار والمودة. عتبي كبير على عنود التي انقلب ودها إلى خبث مجهول المصدر، صارت تمارسه بالتدريج علي، معرضة إياي لضغوط نفسية فظيعة. لن أخشى من رفع مستوى الضرر الذي ستلحقه بي عنود حين تفرأ مذكراتي فتدرك أنها المقصودة بما تحمله من عتاب على غياب حسن الخلق من جانبها بعد أن كان رفيق صداقتنا التي تحولت إلى علاقة الرئيس الجائر بالمرؤوس المظلوم.
سأكتب النصائح والعبر والحكم في مذكراتي، وسأقول: حين نتعامل بأخلاقنا التي تربّينا عليها من احترام الآخرين وتقدير النظام والتأدب في الحديث والصدق في العمل والإخلاص في المودة تجاه الناس والوطن، نتفاجأ عندما نقوم بكل ذلك ولا نجد سوى الندرة ممن يدركون نزاهة وقيمة هذه المعاني السامية، فتتسلل الخيبة إلى دواخلنا.
الكثيرون لا يعترفون بهذه القيم وهذه الصفات الجميلة. لماذا؟ لأن العجرفة الجوفاء والنفاق المتنكر بأزهى الثياب المبهرة والسلوكيات المبهرجة هو الواقع الدامي الذي فرض ذاته على النفوس.
خلال حياتنا المؤقتة على كوكب الأرض تصادفنا العديد من النماذج البشرية التي تزيل الغشاوة عن أعيننا لنكتشف بأن البشر ليسوا، ولن يكونوا في يوم من الأيام، من الملائكة، وتتوالى الاكتشافات لتصل في الختام إلى نتيجة مفادها أن الخير يتآكل في النفس البشرية رغم أن فيه يقيم الأمل، فالله سبحانه وتعالى أرادنا أخياراً، ولكن بكل أسف استغل الإنسان نعمة العقل التي وهبها الخالق له، واستثمرها بالشر وبأبشع الصور ليفترس بالخبث نوازع الخير في داخله ودواخل الآخرين كلما كان الضمير في غفوة.
يا أيها الإنسان أفق قبل فوات الأوان، فما أظلم النفس البشرية حين تبيت في سبات الظلم والضغينة.
يا أخي الإنسان أفق فإن العدل والمحبة هما كينونة الوجود، لولا أن الرب أحبنا لما كنا وُجدنا على هذه الخليقة؛ لولا أن والدينا أحبوا بعضهم بعضا ما كنا خرجنا إلى هذا الوجود؛ ولولا أنهم أحبونا ما كنا كبرنا وصرنا قادرين على التنكيل بالكون الذي تملكنا أرضه الشاسعة لنصول فيها ونجول.
سأكتب: يا أخي الإنسان، أحبب نفسك وأحبب الآخرين، أفق أرجوك، أفق من سبات ظلمات نفسك القاسية، وتذكر بأن الحياة أقصر من أن نضيعها في الكره، وفي الظلم، وفي الكذب.
أحبب نفسك يا أخي الإنسان كما أحبك الله فكوّنك بأحسن الصور، فيا أخي في البشرية لا تنسَ أن الله محبة، والمحبة خير، وهي السبيل الوحيد لاستمرار الوجود، فما نفع البغض والضغينة؟ وما نفع الحرب والدمار؟ وما نفع المؤامرات والنميمة؟
كثير من الدول تهدمت نتيجة لهذه الشرور، فما بالك بالإنسان؟ ما أسهل أن يتحطم الإنسان في داخل كل منا نتيجة لهذه النواقص.
أفق يا أخي الإنسان وتذكر بأن الرحلة على هذه الأرض قد تصل إلى نهايتها في أي لحظة، فلا تنسَ ذلك وأحبب نفسك، وأحبب قريبك، وأحبب زميلك وعملك ووطنك، وأخلص للوجود.
نعم، سأكتب في مذكراتي عن كل خواطري ومشاعري بشفافية وصدق، ولكنني لن أذكر حقيقة ما يدور بيني وبين زوجي الذي يبدو في أعين الناس بصورة الرجل الطيب والمثقف والمتفهم والحنون. فهو برأيهم نعمة كبرى. لن أكتب عما حدث ليلة الأمس عندما عدنا الى المنزل بعد حضور المسرحية. سأكون صريحة في مذكراتي ولكنني لن أقول شيئا عن تقلبات مزاج زوجي المفاجئة التي تصل أحيانا إلى حد الجنون نتيجة إدمانه للخمر.
لن أتحدث أنه بعد عودتنا بقليل، وبعد أن انتهى زوجي من ضربي لكونه سكر؛ كعادته في كل ليلة، في هذه المرة ضربني لأنني تأخرت في إعداد العشاء. لملمت ألمي وبكيت في صمت وجلست لأشاهد معه التلفاز. لقد اعتدت أن أخفي عن الجميع حقيقة أنه يسكر إلى درجة تفقده صوابه فيتحول إلى كائن غريب لا يدرك مدى الأذى الذي يلحقه بي. وليلة الأمس بالذات ألقى بجسده المنهك من ضربي على المقعد بجواري بعد أن هدأ. بدأت يداه تبحثان عن أي شيء يضعه في فمه ليلهيه عن قلقه بانتظار بث البرنامج التلفزيوني الذي شارك فيه حول تمكين المرأة، وجد قطعة «ملبَّس» نزعها من غلافها الملون ووضعها في فمه.
قدمت المذيعة المشاركين في الندوة التلفزيونية: الكاتبة والشاعرة فلانة المناضلة للدفاع عن حقوق المرأة، الدكتور (زوجي) المهتم بشؤون المرأة، والأستاذة فلانة التي تسعى لتغيير القوانين لصالح المرأة. الدكتور، زوجي، يرى بأن الأعراف والتقاليد هما السبب في غياب بعض حقوق المرأة. والكاتبة الشاعرة تؤيد هذا الرأي بشدة وتطالب المرأة بأن تثور على الوضع السائد، أما الأستاذة الضليعة في القوانين فترى بأن التقاليد فقط هي السبب، والقانون بإمكانه تغيير الوضع وقلبه رأساً على عقب.
في داخل الشاشة شاهدت زوجي يقول وهو يضع ساقا على ساق: أنتم تطالبون بمساواة المرأة بالرجل، المهم أن نصل إلى مساواة الإنسان بأخيه الإنسان بدون التفريق بين رجل وامرأة، الإنسان بصورته المجردة هو الأهم.
آه ... يا إنسان.
***
هنا تنكّس المرأة رأسها، ويسدل الستار، وتنتهي المسرحية.