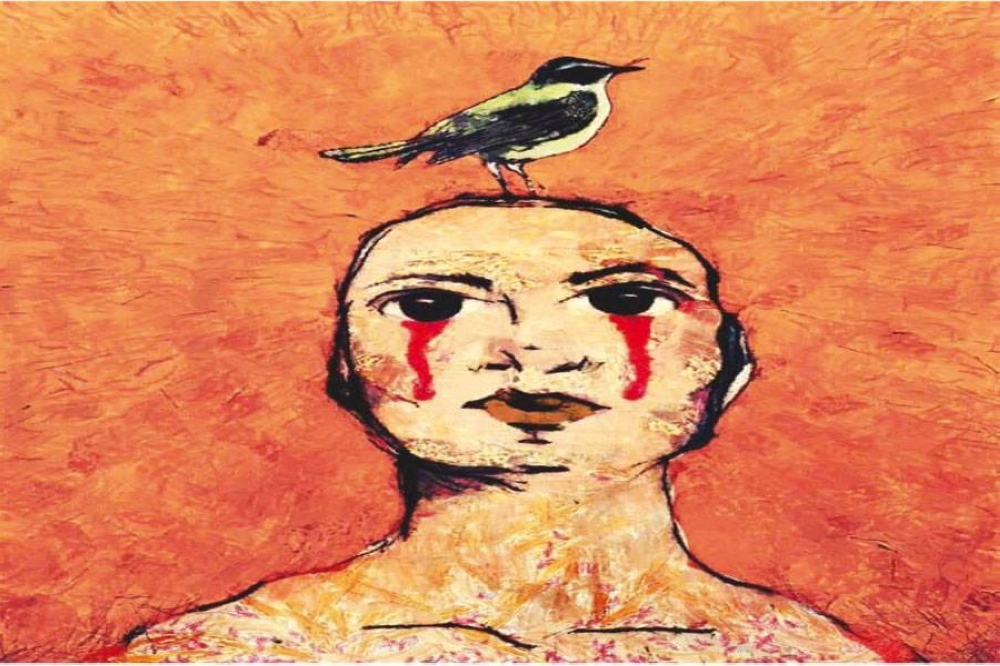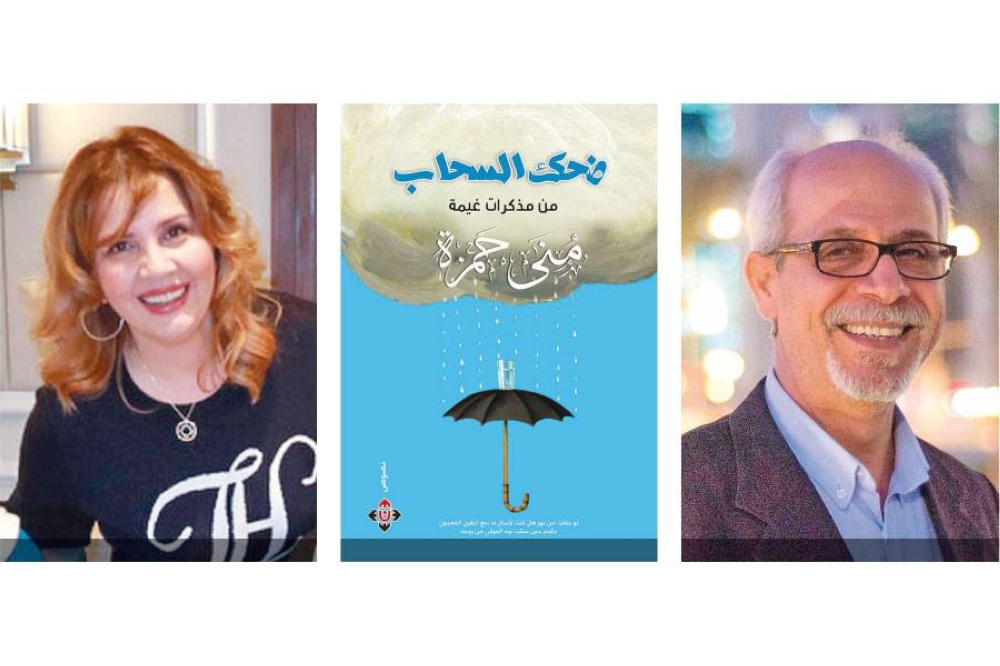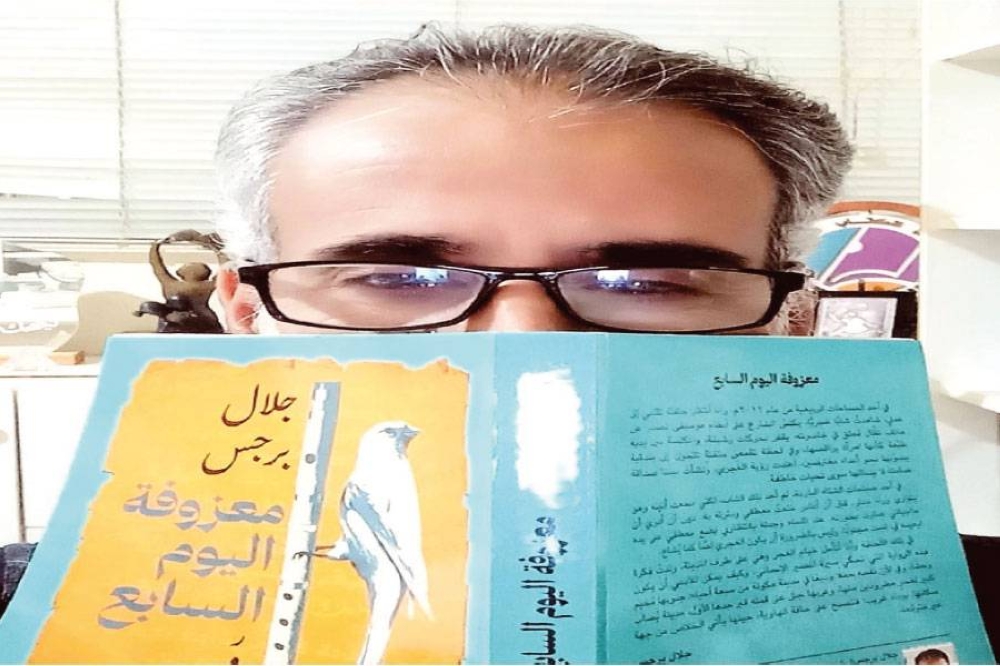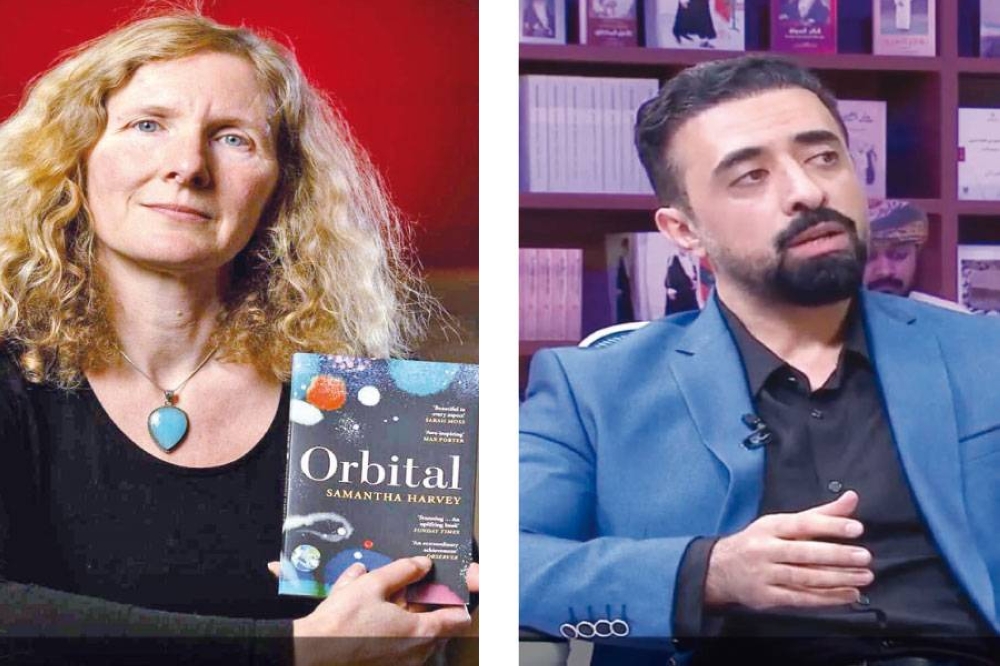بعد أن نجحت روايتها الأولى «الحرب التي أحرقت تولستوي» كأول رواية عربية تشير إلى الأحداث الدائرة في اأكرانيا، وروايتها الثانية «العبور على طائرة من ورق» التي تناولت قضايا اجتماعية ونفسية ولم تخلُ من طرح مواضيع مهمة وحسّاسة، تعود الينا الروائية زينب السعود في روايتها الثالثة «نطفة في قلب غسّان كنفاني» التي يلمس القارئ فيها بوضوح مدى النضج الفني والروائي للكاتبة وأن قلمها يسير قدما من خلال تطور كتابتها.
نرى قلم السعود في هذه الرواية مختلفا عن سابقتيها فيما يخص الأفكار والمواضيع التي ناقشتها الرواية، إضافةً إلى وجود تقنية سردية مميزة. فبالرغم من صعوبة سرد هذا النوع من الأحداث التي نظن أننا نعرفها، إلا أنها تفوقت على فكرة «المعتاد» وصنعت رواية ممتعة لغوياً بحبكة درامية شيّقة ومؤثرة عاطفياً في روح القارئ العربي.
ففي هذه الرواية تتناول الكاتبة مواضيع اجتماعية بخط موازٍ للرسالة الأكبر في النص وهي القضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب من الظلم والظروف الإنسانية السيئة.
أثناء القراءة ستشعر أن هناك خطَّين متوازيين يعملان جنباً إلى جنب في صناعة الحبكة وذروة المشهد: الخط الأول يتمثل في الصراعات والخلافات الاجتماعية ما بين أفراد الأسرة وبشكل أكثر خصوصية بين ندى الزوجة، وغسّاني كنفاني الزوج. والخط الثاني يتمثل في مقاومة الفلسطينيين بشكل عام والغزيين خاصة. وإذا أردنا استخراج نقطة التقاء بين الخطين في الرواية، أستطيع القول إن الكاتبة تريد أن تقول بشكل أو بآخر على لسان الفلسطينيين: «نحن بشر وأناس طبيعيون، ولسنا بشرا بقدرات خارقة، وكل ما نريده العيش بسلام وإيجاد نوع من الحياة الطبيعية. فلدينا ما يكفينا من مشاكل اجتماعية كبقية المجتمعات».
•ثقافة المكان في الرواية
إذا أردنا أن نتحدث عن بيئة الرواية، نجد الكاتبة استطاعت من خلال السرد ووصف التفاصيل لحركة الشخصيات، أن تجعل القارئ يعيش وسط بيئة الإنسان الفلسطيني العادية، فنرى عدّة إشارات تشعر القارئ بالنمط الاجتماعي السائد في المكان من خلال ذكر العديد من المدن الفلسطينية: حيفا، ويافا، وشوارع مدينة غزة، وبعض المرافق المكانية (مستشفى الشفاء)، ومدارس الوكالة. وفيما يخص الجانب الثقافي نرى العديد من الاقتباسات من محمود درويش وغسان كنفاني وكتّاب آخرين مثل تميم البرغوثي بالإضافة إلى جبران خليل جبران وإلياس خوري ممكن يشكلون حضورا في الثقافة الفلسطينية.
كما أشارت الكاتبة إلى العديد من الأمثال والحكم الفلسطينية (اجرِ جري الوحوش غير رزقك ما تحوش)، وبعض الكلمات (مجعلك)، وبعض التفاصيل الصغيرة لكنّها تستحق الذكر، مثل تعريف القارئ بالأعشاب والنباتات الفلسطينية التي تتداولها الأمهات بقدسية كأنها الدواء لكل داء. هذه الإشارات تجعل القارئ يتعرف أ كثر على بيئة الرواية الجغرافية والثقافية معا. ويجب القول بأن رسم البيئة بهذا الشكل سلاح ذو حدين ويجب على الكاتب أن يعرف متى يقف وأين، وهذا ما نجحت فيه الكاتبة.
•السرد
اعتمدت الكاتبة على تقنية السارد الأول (المتكلم) وأدارت الحوارات بين الشخصيات بطريقة تكشف فيها كل شخصية عن ملامحها وأفكارها، كما أنها لم تلتزم في السرد المنضبط زمنياً، فنرى هناك سرداً للأحداث ما بين الماضي (التسعينات والألفية الثانية) والحاضر (أكتوبر ٢٠٢٣)، والعديد من القفزات الزمنية. وللوهلة الأولى يشعر المرء بأن كثرة التنقلات ما بين الماضي والحاضر وفي فصول متقاربة جداً قد يسبب ضياع التركيز. ولكن عندما نبدأ في الفصل الأخير، وهو الفصل الكاشف لكل الحقائق، نعرف لماذا اتخذت الكاتبة هذا الأسلوب، لقد جعلت من هذه?القفزات جزءا من الأحداث بطريقة صادمة ورائعة في الوقت ذاته، ويحسب لها إبداعها في إدارة السرد بهذه الطريقة الشائكة والجميلة.
•شخصيات الرواية
إذا أردنا التركيز على الشخصيات الروائية وتحليلها، سنجد شخصيتين رئيسيتين (ندى وغسّان)، ومن خلالهما يتم طرح العديد من الأفكار، ونرى هذين الزوجين يمثّلان قطبين متضادين في كل شيء، إلا أنهما يتقاطعان في حيز ضيق متسع هو حب الوطن، كل على طريقته، مما جعل العلاقة بينهما تصل كثيرا إلى طريق مسدود، لكن الحب الذي باستطاعته إذابة العقبات يجعل الحياة تستمر إلى الحد الذي تصبح فيه الأشياء أزمات مزمنة، فكيف ستكون نهاية قصتهما في هذه العلاقة؟
ندى بتفكيرها العاطفي وقوة شخصيتها الموروثة من والدها والمحبة لجغرافيا الوطن والتي تمنح نفسها أحقيّة وتفويضا في الدفاع عن الأرض حتى وإن كان على حساب حياتها الشخصية، والزوج غسّان، الذي يعاني من اسمه المركب أشد معاناة، فهذه المقارنة الدائمة بينه وبين الأديب الراحل غسّان كنفاني جعلت منه ساخطا على هذا الرمز (كنفاني)، وعند الوصول إلى الفصل الأخير تتكشف الحقائق ونفهم سر هذا السخط.
وإذا أردنا أن نقول إن هناك بعض الأسئلة التي تتولّد عند القارئ أثناء القراءة لما بين السطور والتدقيق في التفاصيل الصغيرة، فسيكون التساؤل في هذه الرواية، مدى أحقيّة الفلسطيني في اتخاذ قرار الهجرة من الوطن؟ ومدى قبول الرأي القائل بأنه نوع من الخذلان للجغرافيا والتاريخ والقيم، وما بين هذا وذاك تساؤلات عديدة وإجابات متعددة ولّدها النص في ذهني.
هذه الرواية ممتعة في قراءتها، ورائعة في لغتها، ومشوقة في أحداثها، ومهمة في تساؤلاتها، وإذا أردنا معرفة العلاقة بين الكلمات الثلاث (الحب، الأسماء، الفقد) فلنقرأ هذه الرواية.
(كاتب من الكويت)