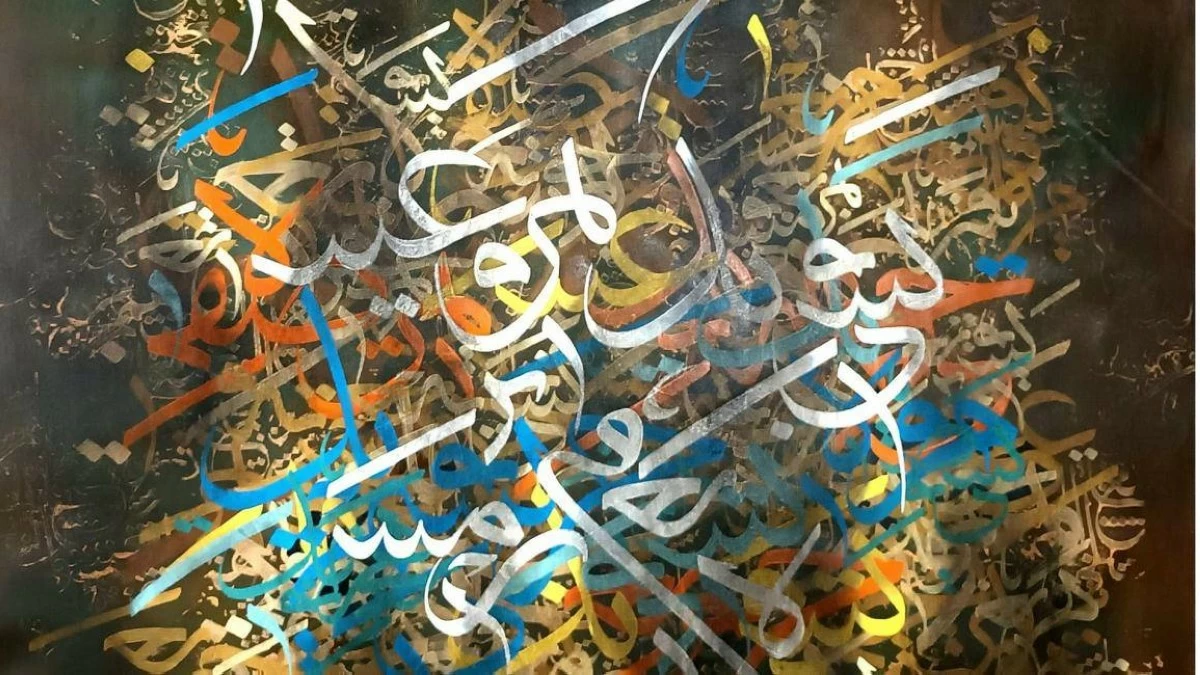في عالم الفكر والثقافة، تتجاوز اللغة كونها مجرد أداة للتواصل لتصبح وعاءً حضاريّاً يحتضن عبقرية الشعوب وتراثها الثقافي. إنها مرآة تعكس عمق تفكير الإنسان، حيث يُعبّر اللّسان عن القدرة على الإبداع والتّعبير، ويستمد جماله وقوته من جذور التّراث وتفاعلاته الاجتماعية والثّقافية. وهكذا تتبلور مقولتي (العبقريّة في اللِّسان واللّسان في مَضَضٍ) لتؤكد أن اللغة ليست تجميع للكلمات، بل نتاجٌ حضاريّ ينبض بالرؤية الفكرية والرّوح التراثية.
تواجه لغتنا تحديات جسيمة تهدّد تماسكها وجذورها العميقة، في ظلّ التّحوّلات الرّقميّة السّريعة والعولمة التي تجتاح العالم، مما أدّى إلى انحراف مفاجئ في مسارها، ما جعل اللّسان يتجه نحو حالة من (المَضَضِ)، فيغدو في حالة اضطرابٍ ووجعٍ واغتراب، وكأنه يتأرجح بين البقاء والضّياع. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف نعيد للّغة ثباتها في مواجهة هذه التحديات؟ فأين مَن ذا يرشد ويعيد للّغة رونقها وثباتها!
العبقرية في اللسان: إبداع الفكر والتّعبير
تشير الدّراسات اللّغوية إلى أن اللّسان ليس مجرد أداة تواصل، بل هو وسيلة العقل في التعبير عن رؤاه وتجليّات إبداعه. وقد عبّر «ابن جني»، أحد روّاد علم اللّغة في التّراث العربي، عن هذا المفهوم بقوله: «اللّسان مرآة العقل، فكلما ارتقى الفكر زاد بهاء التّعبير، فيه تنطق العبقريّة في النّصوص والقصائد والحوارات"؛ مما يؤكّد العلاقة الوثيقة بين الفكرِ واللّغة، حيث يعكس التعبير اللّغوي عمق الإدراك الفكري للإنسان.
وفي السياق نفسه، يرى «فرديناند دي سوسير» في كتابه «دروس في اللسانيات العامة» (1916) أن اللغة «ليست مجرد مجموعة عشوائية من المفردات المتناثرة، بل هي نظام متكامل تحكمه قواعد داخلية تعكس بنية الفكر المجتمعي وتتيح توليد معانٍ بديعة، وهو ما يمنحها صفة العبقرية الفكرية». وهذا يؤكّد أن الإبداع اللّغوي ليس منعزلاً عن الإطار االثقافي والحضاري الذي ينشأ فيه، بل هو انعكاس لطريقة إدراك الشعوب للعالم من حولها. فكل لغة تعكس رؤى أهلها وتُجسّد عمق تفكيرهم.
واللسان بوصفه أداة للتعبير، يعدّ الجسر الذي يربط بين العالم الداخلي للفرد والعالم الخارجي. لكن هذه الأداة لا تتجلى قوتها إلا من خلال «العبقرية اللغوية»، أي القدرة على منح الكلمات حياة جديدة وتحويلها من مجرد رموز إلى أدوات تثير المشاعر وتلهم. يقول الفيلسوف لودفيغ فيتجنشتاين: «حدود لغتي تعني حدود عالمي»، مما يبرز دور اللّغة في توسيع آفاق الفكر والتعبير. لذا، فإن «العبقرية اللّغوية» لا تكمن فقط في إتقان اللغة، بل في القدرة على تطويعها إلى فنّ قادر على التأثير والإلهام.
من هذا المنطلق، فإن قوة اللّغة لا تكمن فقط في ألفاظها وتراكيبها فحسب، بل في عمقها الدّلالي وقدرتها على نقل الأحاسيس والأفكار وتجسيد رؤى العالم المختلفة. لذا، فإنّ الحفاظ على أصالتها وتطويرها أمراً ضرورياً، ويعدّ مسؤوليّة ثقافيّة تضمن استمرارية التّراث الفكري في مواجهة التّحوّلات المعاصرة، مما يساهم في إثراء الإبداع اللغوي وترسيخ مكانته في الفكر الإنساني.
اللغة القيّمة الغنيّة وتنظيمها على أساس التّفاعل الاجتماعي والثّقافي
تُظهر العديد من الدّراسات أن اللّغة القويّة والقيّمة تتبنّى نهجاً يعتمد على التّفاعل الاجتماعي والثّقافي، إذ تُعاد صياغتها وتطويرها مع تغيّر أنماط الحياة. وفي هذا الإطار يقول أحمد أبو عبيدة: «اللغة كائن حيّ يتنفس مع كلّ تفاعل اجتماعي؛ فهي تتشكّل وتتعاظم مع انسياب الثّقافة بين أفراد المجتمع».
وهكذا، فإن قوة اللغة لا تنبع من بنيتها فحسب، بل من تفاعلها المستمر مع المجتمع، مما يمنحها قدرة حيوية على التعبير عن المشاعر والتجليات الفكرية.
•اللّسان في مضض
-بين ثِقل التّراث وتحوّلات العصر
تتجلّى أزمة اللسان في التوتر المستمر بين سلطته التراثية وضرورات التحوّل التي يفرضها الواقع المعاصر. فاللّغة كيان ثقافي ومرآة للتحولات الاجتماعية. يرى «إدوارد سابير» أن اللغة ليست مجرد أداة، بل نظامٌ معرفي يشكل إدراك الإنسان للعالم ويحدد أسلوب تفكيره. وهذا يعني أن (المضض) الذي يعتري اللّسان هو تجلٍّ لصراعٍ جوهري بين الثّابت والمتغيّر.
هذا الصراع يظهر جلياً في التحولات الدّلالية التي طرأت على مفردات أساسيّة في اللغة العربية. فكلمة «المهابة» التي كانت تُستخدم للإشارة إلى الاحترام المشوب بالخوف، باتت اليوم تحمل دلالاتٍ توحي بالتّردد والارتباك؛ ما يعكس تغيّر المفاهيم والوعي الجمعي المعاصر. ويرى «رومان جاكوبسون» أن التغير الدّلالي ليس مجرد ظاهرة لغوية، بل هو انعكاس للتّحولات الفكرية والاجتماعية التي تعيد تشكيل المعاني وفق حاجات العصر.
المضض كحافز للإبداع اللّغوي وتجديد المفاهيم
إذا كان المضض في اللسان يُعبّر عن أزمة بين الجذور والتطور، فإن هذه الأزمة ليست بالضرورة مؤشراً على التّراجع، بل يمكن اعتبارها عاملاً دافعاً لإعادة تشكيل اللغة وإثرائها. فالتّحولات التي تطرأ على التراكيب والمفاهيم لا تعني القطيعة مع التراث، بل تؤكد قدرة اللّغة على التكيّف والعصرنة، مع المستجدات الفكرية. يذهب ميخائيل باختين إلى أن المعنى اللغوي لا يُحدَّد في ذاته، بل يتشكل ضمن الحوارية التاريخية بين الأجيال والمجتمعات، وهو دائماً في «حالة إعادة تأويل».
إن ولادة مصطلحات جديدة مثل «التفكيك» و"التواصلية»، التي لم تكن مألوفة في المدوّنات اللغوية الكلاسيكية، تدل على أن اللّغة قادرة على تجاوز أزمتها الذاتية عبر إعادة إنتاج دلالاتها وفق الحاجة المعاصرة. ويرى «ويليام لابوف» أن تغير اللغة ليس مجرد اضطراب، بل هو عملية دينامية تعكس التفاعل الاجتماعي والسياسي، وتُعيد تشكيل بنية المعنى بما يتلاءم مع المستجدات.
استدامة (المضض) كحالة إبداعية
إن المضض الذي يعتري اللّسان العربي ليس ناتجاً عن خللٍ داخلي، بل هو جزء من سيرورة التطور الطّبيعي لأي لغةٍ حيّة. ومع ذلك، فإن الحفاظ على توازنٍ بين الأصالة والتّجديد يتطلب وعياً نقدياً يُعيد تأصيل المفاهيم دون أن يفرط في الاستسلام لمتطلبات العصر. وكما يرى عبدالسلام المسدي فإن الحفاظ على الهوية اللّغوية لا يكون بالجمود، بل بإعادة إحياء روح اللّغة ضمن معطيات الزّمن الجديد، حيث يُعاد بناء المصطلحات بما يتناسب مع روح العصر، دون أن تفقد اللّغة مرجعيتها التاريخية.
وهكذا، فإن إصلاح ما أفسدته تحوّلات العصر لا يعني رفض التّجديد، بل يتطلب إعادة توظيف المضض اللّغوي ليكون عنصراً مبدعاً يعيد للّسان حيويته، بحيث يظل في حالة عدم ركون، لا يتوقفّ عن التحوّل، لكنه لا ينفصل عن جذوره، محققاً التّوازن بين موازين التراث ورهانات العصر.
تأثير الرّقمنة على اللّغة
مع تسارع وتيرة العصر باتت الحاجة كبيرة وملحّة على التّحديث لمواكبة العصر الرّقمي، بدأت اللّغة تواجه تحديّات عدّة من حيث الحفاظ على عمقها التّراثي وجودتها التّعبيريّة. فقد لاحظ الباحث أحمد سليمان أنّ الرّقمنة أدت إلى ظهور ظواهر لغويّة جديدة، مثل الاختصارات والرّموز الرّقمية، مما قد يؤثر سلباً على القدرة على التّعبير العميق المُعتمد على التّراث الأدبي واللّغوي.
تتيح الرّقمنة فرصاً للإبداع والتجديد، لكنّها تهدد ارتباط الأجيال الجديدة بجذورهم اللغوية، مما يستلزم تحقيق توازن دقيق بين الأصالة والتطور. هذا التحول الرقمي يفرض علينا سؤالاً مهماً: كيف نوازن بين الحفاظ على الهوية اللّغوية والانفتاح على العصر الرقمي؟ وهل يمكن للرقمنة أن تكون حليفاً للغة بدلاً من تهديدها؟"
على سبيل المثال، في المجتمعات المعاصرة، أدت الرقمنة إلى ابتكار مصطلحات جديدة كـ «التغريد» و"الهاشتاغ» التي تعكس التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يُظهر قدرة اللغة على التكيّف والإبداع بناءً على الاحتياجات الثقافية والتكنولوجية. وبذلك، يمكن القول إن اللّغة تمثل تفاعلاً مستمراً بين الوعي العقلي والتقاليد الثقافية، حيث تتجاوز كونها أداة ثابتة لنقل المعاني إلى كونها بنية ديناميكية تولّد مفاهيم جديدة باستمرار.